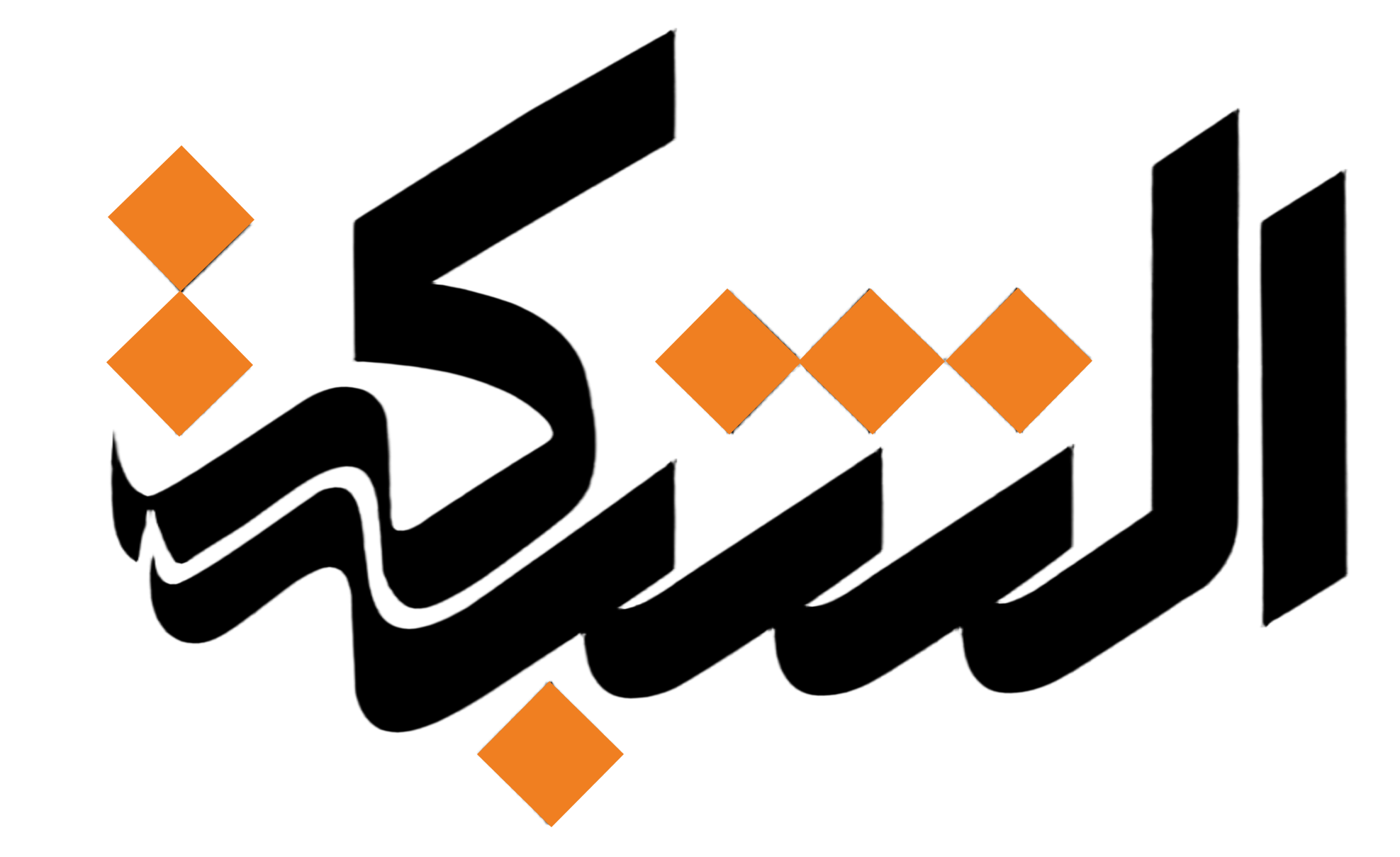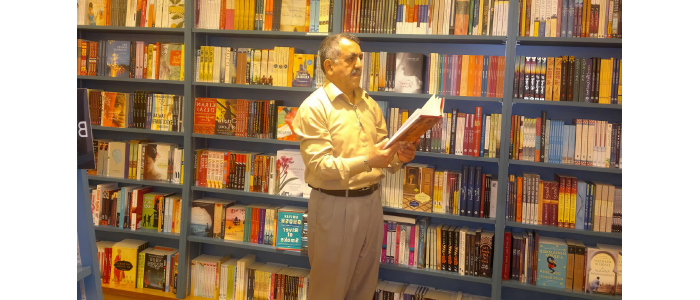100%
حوار/ مؤيد الطيب
يقول الروائي الكولومبي الكبير غابرييل غارسيا ماركيز ""ذات ليلة، أعارني أحد الأصدقاء كتابًا من القصص القصيرة للكاتب (فرانز كافكا). ذهبت راجعًا إلى النزل، حيث أقيم، وبدأت بقراءة (المسخ). لقد سقطت من الفراش بعد قراءة السطر الأول، لقد كنت مدهوشًا. كتب (كافكا) في السطر الأول من روايته (استيقظ غريغور سامسا في صباح ذلك اليوم من كوابيسه، وقد وجد نفسه قد تحول في فراشه إلى حشرة ضخمة). عندما قرأت هذا السطر قلت لنفسي إني لا أعرف أي شخص باستطاعته كتابة أشياء كهذه."
وبرغم الاندهاش الكبير لماركيز برواية كافكا، إلا أنه أخذ على عاتقه إدهاش العالم بخياله الواسع في رواياته، وجعل القرّاء حول العالم يتساقطون من أسرّتهم مندهشين من سحره. وهذه هي مهمة الكاتب الفعلية، أن يرفعوا أجسادنا من مواضع جلوسها إلى سماء خيالهم الكبيرة وإسقاطنا، نحن القرّاء، من الأعلى، عائدين إلى الواقع بتساؤلات كثيرة. وهو كذلك ما فعله الروائي المصري محمد سمير ندا، في روايته (صلاة القلق) الحائزة على جائزة البوكر للرواية العربية لعام 2025. رواية حملت همًا ليس مصريًا فقط، بل هم عربي، يشاركنا من خلاله ببوح الكثير من الأسرار والأسئلة، أسرار ربما هي واضحة أمام أعين الجميع، لكنها تحتاج لصرخة روائي لتعريتها أمامنا، وأسئلة في الحياة العربية، يدور فيها بين أروقة السياسة، وحتى غرف نومنا الهادئة، ليوقظ في رؤوسنا الكثير من الأفكار، مثل الشيخ أيّوب المنسيّ، الذي استيقظ صباحَ يوم ما، فلم يجِدْ رأسَه بين كَتفيه. كما ورد لنا في سجلات روايته "(صلاة القلق)".
محمد سمير ندا، الروائي المولود في بغداد سنة 1978، يتحدث لـ "الشبكة العراقية" في هذا الحوار عن بغداد الولادة، وأبيه المعلم، والخوض في غمار الكتابة بين الحقيقة والخيال وجنون ومتعة السرد.
* محمد سمير ندا.. كيف تصف العودة لبغداد؛ مكان الولادة ورحم التكوين الأول؟
-حلم عمره أربعة عقود! لا أكاد أصدق أنني سأزور بغداد أخيرًا، أصدقائي المقربون يعرفون ذلك، فلطالما قلت إنني أتمنى أن أزور بغداد مرة أخرى، ولو لمرة واحدة قبل الرحيل. في بغداد تكوّن الوعي الأول، وعلى الرغم من الخوف والقلق في ظل الحرب مع إيران، في ثمانينات القرن الماضي، إلا أنني لم أعد إلى القاهرة سوى بذكريات سعيدة عن هذه الفترة، ست أو سبع سنوات أذكر فيها مرحلة الروضة، وصافرات الإنذار والأمان، ومعارض المعدات الحربية، كما لا أنسى أن أبي قد طبع في بغداد واحدة من أهم رواياته، (حارة الأشراف).
* سعيدون بنيلك البوكر عن روايتك (صلاة القلق).. ماذا تعني لك الجائزة؟
-تكريم واعتراف بأنني أحاول أن أقدم شيئًا ذا قيمة، الجائزة تسلط الضوء على الكُتّاب، وتوسع من دائرة المقروئية لأعمالهم، شيء عظيم في واقع الأمر، ونشوة لا ينكرها إلا كاذب، خصوصًا وقد تلقيت الاعتراف بقيمة ما أكتب، وأنا لم أزل في مستهل مشوار الكتابة، هذا توفيق كبير لا يمكنني إغفاله، ولكن، الجوائز لا تضمن الجودة، أي أنها لا تمنح الكاتب صكَّ اعتراف دائم، ولا تهبه الخلود، بل هي اعتراف بجودة نصٍّ كتبه الروائي، ومكافأة مالية قيّمة، ثم؛ لا أكثر من ذلك. يحلم كل كاتب بأن يكتب أعمالًا تعيش أطول منه، فتمنحه الخلود باستمراريّة الأثر الذي تركه، والجوائز لا تحقق هذا، إنما هو الزمن، الزمن يفرز ويقيّم ويقرّر أي الروايات تعيش طويلًا، وأيها تتراص في أرفف النسيان، هذا ما يشغلني، وأعمل على تحقيقه.
*أين يكون الروائي بين الفوز بجائزة عن روايته؟ وإنجاز الرواية في الأساس؟
- مرحلة طويلة، عمل من دون ضغوط، أخذ كامل الوقت في مراجعة وتعديل وتحرير النص، ثم لا شيء! انشغالي الوحيد ينصب على الرواية، أود أن تخرج الرواية بأقل قدر ممكن من العيوب أو الأخطاء، عملت طويلًا على ربط الأحداث وتقديم وجهات نظر متباينة حيال حدث واحد، ومحاولة التجريب، أو الكتابة بخط مختلف عن كل ما قرأت، عقب سنوات في هذا العالم الذي أنشأته، تكون لحظة الخروج من هذا العالم وتقديمه إلى القارئ هي أصعب مرحلة على الصعيد النفسي، لست ممن يسعدون بإنجاز الرواية فور الانتهاء منها، على العكس، أصاب بالاكتئاب كأن مساحة من الفراغ جعلت تتمدد في داخلي. لم أفكر في الجائزة، ولم تشغلني مواعيد الترشح، والحقيقة هي أن الناشر هو من أصر على تقديمها، بينما تصورت أنا ألا حظوظ بالفوز لرواية تناقش أمرًأ سياسيًّا. ولكن لحسن الحظ، كان للّجنة رأي آخر.
* حدّثنا عن حكيم ابن الخواجة، وما يعني لك كونه الصامت الذي حكى كل شيء بالكتابة في (صلاة القلق)، وما مدى وجودك في شخصيته؟ وسؤالي ينطلق من عدم وجود الراوي الأصلي وقد تلخص بحكيم نفسه!.
- كلانا امتداد للآخر، لأنني أمارس فعل الكتابة بصفة دورية ارتكازًا إلى نصيحة معالجي النفسي، وكذلك فعل حكيم. وددت أن أقول إن الحكيم في هذا الزمان، أو شاهد العدل؛ أخرس، لا يقدر على نقل الحقيقة، ولو تجرّأ على الحكي، لما وجد من يسمع أو يقرأ شهادته! حكيم هو صوت الشعوب إذ يبوح بالحكايات التي لم ترو، والحقائق التي زيّفها المؤرخون بإملاء من سجّان، أو بإيماء من سلطان. هو الراوي الأصلي والحقيقي الوحيد في الحكاية، ولعله أراد أن يستعيد لسانه المقطوع من خلال استعارة ألسنة الناس، ليروي الحقيقة، علّه بذلك يبدد غيوم القلق المخيمة على سماوات العرب منذ سنة 1948.
* في تجربة "(صلاة القلق)" ونجاحها.. كيف تنظر لأعمالك السابقة والمقبلة؟
- حسنًا، أظن أنني أتعلم، وأعتقد أنني -من خلال القراء- أتعلم، وأمارس التجريب والتنويع بجرأة أكبر. روايتي الأولى لا أنصح أحدًا بقراءتها، لأنها تعج بالأخطاء والهفوات والإسهاب، لكن روايتي الثانية كانت أفضل كثيرًا، وهي بالمناسبة تروي سيرة أبي رحمه الله، لذلك فهي تتنقل بين السعودية والعراق وليبيا. في "(صلاة القلق)" كنت أكثر تحرّرًا، لأنني بحت أخيرًا بحكاية سمير ندا في الرواية السابقة لها، شعرت أنني أكثر خفة، وقد تخففت من حكاية أبي التي كانت تؤرقني منذ الطفولة، ظلم هذا الرجل كثيرًا، وكان من الحتمي أن أقص حكايته. الأعمال المقبلة تحمل ذات النهج المتحرر، والرغبة في التجريب، وهي بدورها تسائل الإنسانية برمّتها عن شيوع الوحشيّة واستباحة الدم.
* في الرواية العربية.. هل يكون عنصر تعرية المجتمع من محاذيره ومصدر مخاوفه مصدر نجاح للرواية؟
- الإهداء في "(صلاة القلق)" كان لجموع الصامتين، الذين شهدوا على كل تاريخ لم يكتب بعد، والأمر هنا كما ينسحب على الماضي، فهو معني كثيرًا بالحاضر والراهن، ذلك لأن اللحظة التي نتحدث فيها الآن، لم تصبح تاريخًا ولم تكتب بعد، انطلاقًا من هذه الرؤية الشخصية، أحب أن أحرّض القارئ على أمرين؛ تقليب تربة التاريخ وإعمال العقل قبل النقل، ثم الحرص على تدوين ما يجري، أي أنهم مطالبون بتدوين تاريخهم قبل أن تناله يد التزييف. تعرية المجتمع أمر حتمي لكل من يحلم بالتقدم والتطور، لا يمكنك السير لو ظللت مكبلًا بأصفاد الماضي المفروض عليك، ربما تكون الشؤون السياسية من المحاذير في الكتابة العربية، تمامًا كالجنس والدين، لكنني أعتقد أن "(صلاة القلق)" تحدثت عن الإنسان المتآمر على نفسه بالصمت، الراضخ لقلق يرتكز إلى أوهام وشعارات كاذبة. هل كان التحدث عما هو محظور تناوله مصدر نجاح للرواية؟ بصراحة لا أعرف، إذ تلقيت الكثير من الآراء سلبًا وإيجابًا، وهي كلها آراء متنوعة تحمل من التأويلات ما لا أستطيع عدّه، ولكن، أعتقد أن هذا أمر إيجابي، أعني تعدد التأويلات والرؤية. أما النجاح، فهو التوفيق بالأساس، وما سببه الفوز بالجائزة حسب رأيي.
* كيف تتلمس مدى قناعة المجتمع المصري أو العربي بما تكتب؟ وأين تجد التحفيز عندهم مع كثرة التحفيز الخارجي في مجال الكتابة؟
-قناعات متفاوتة بطبيعة الحال، مصريًا وعربيًا، بعضهم رأى أنني كتبت عملًا فارقًا سيعيش طويلًا، وبعض آخر وجد أنها كتابة مملة وسيئة، وثمة فريق آخر حاكمني وشكك في انتمائي ووطنيتي لما وجدوه من تطاول على الذات الناصرية! التحفيز موجود، وكثير من القراء يحفزونني ويشعرونني بأهمية ما أحاول طرحه، لكني لا أنتظر التحفيز الخارجي، لأن لدي من الحوافز في عقلي ما يكفي وزيادة.
* بمن تأثرت في الكتابة؟ وهل هناك كتابة خالصة وبعيدة عن التأثير الخارجي؟
- حرفيًا؛ تأثرت بكل من قرأت لهم، ولكن بالأساس كان أبي هو الملهم والمعلم، ثم كبار الكتاب الذي قرأتهم في مراحل متفاوتة: محمد المنسي قنديل، وعادي عصمت، ونجيب محفوظ، وآخرون كثر، التأثر موجود بحكم تشابه الهموم وتواردها، لكنني أؤمن أن على كل كاتب أن يمتلك صوتًا وخطًّا مختلفًا، يجب أن تكون لديه بصمة تميزه عن الآخرين. ربما يبدو جيدًا أن يُقال عني "كتابتك تذكرني بأعمال فلان"، ولكن لو كانت أعمالي "تشبه أعمال فلان من خلال المحاكاة والاقتباس" فهذه طامة كبرى.
* محمد سمير ندا.. ماذا بعد "(صلاة القلق)"؟
- المزيد من الكتابة، المزيد من تعرية الذات العربية، المزيد من تصويب البصر نحو مواطئ النسيان العمدي، الكثير من الأسئلة التي أطالب القارئ أن يبحث معي عن إجاباتها. كل هذه المشروعات بدأت قبل صدور "(صلاة القلق)"، وبعد استعادة التوازن إثر ضجة الجائزة وأضوائها، عدت لأستكمل المشاريع التي بدأتها سنة 2023، لأني لن أغير أفكاري، أو أفقد إيماني بما أود طرحه ومناقشته، قررت منذ اللحظة الأولى ألا أسقط في "ماذا بعد"، وعدم التفكير في ما قد يتوقعه القرّاء عن أعمالي المقبلة، أود أن أكتب في ظل ذات الحالة من العزلة والبراح والتحرر من الضغط، وبالتالي فأنا الآن في مرحلة استكمال ما بدأته قبل عامين.