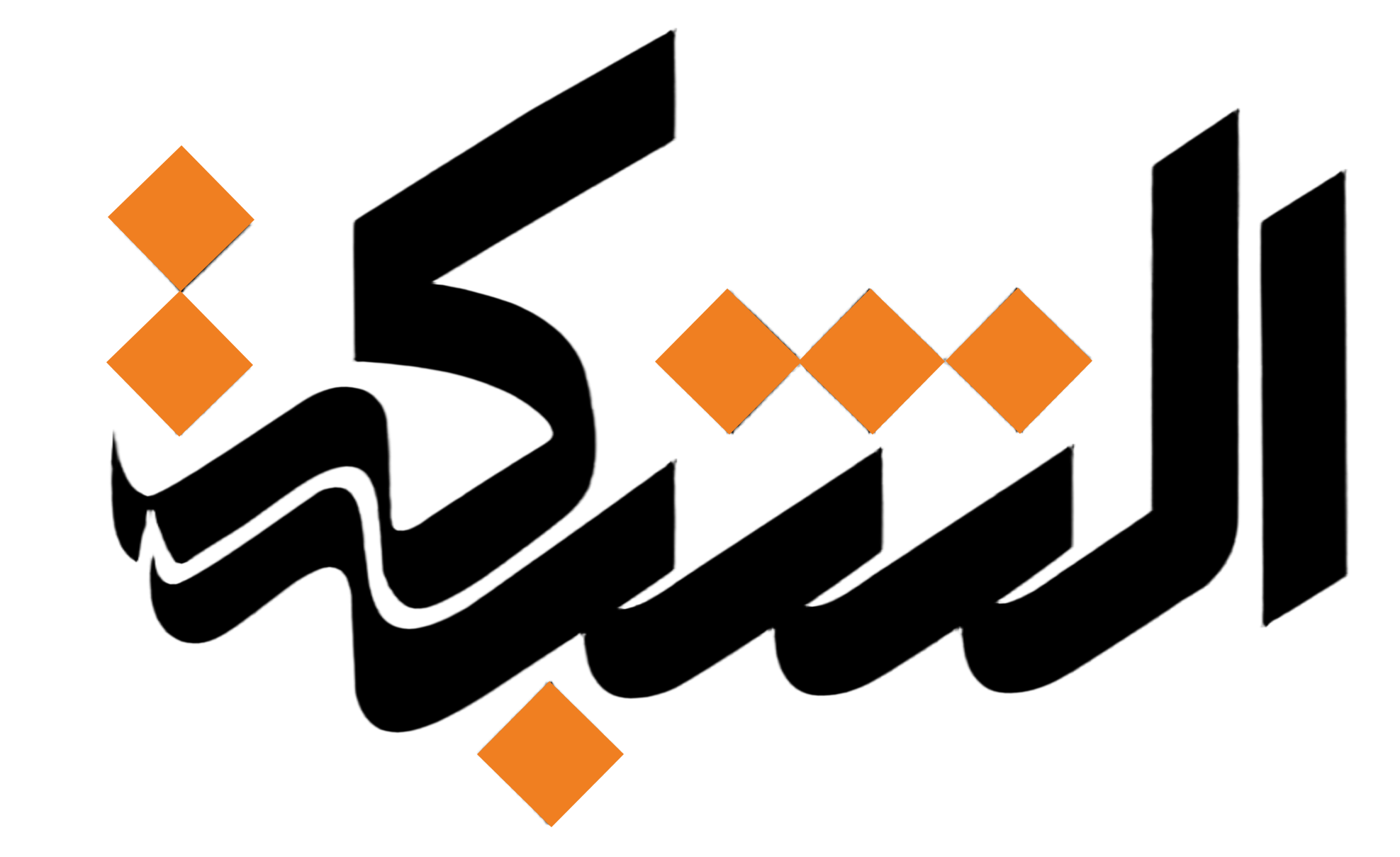100%
مصطفى جواد جياد
تصوير / حسين طالب
عربات تُقاد أحيانًا من فتية لم يبلغوا الحلم، في مشاهد جنونية تخترق آذان المارة بلا رحمة. إلى جانب ذلك، تعلو أصوات البناء والترميم في الأحياء السكنية، وتتصاعد أصوات المولدات الكهربائية التي غزت الأزقة، في مشهد يعكس تغوّل الفوضى على حساب هدوء المدن. حتى أحاديث الناس نفسها باتت أكثر صخبًا، بينما انتشرت المدارس والمعاهد الأهلية في قلب الأحياء السكنية دون دراسة لمدى الأضرار الصوتية التي تتركها على المحيط، لتتلاشى الأرصفة التي كانت ملاذًا للسكينة وفرصة للحوار مع الذات.
لم يعد هناك مكان يحتضن صمتنا أو يرمم هدوءنا. صار سؤالنا اليومي: أين اختفى ذلك السلام الداخلي الذي كان يغمر حتى الأحياء الشعبية؟ وكما قال نجيب محفوظ: "الضوضاء ليست علامة على الازدهار، بل على الفوضى." بالفعل، إنها فوضى الأصوات العالية التي غزت حياتنا وانتصرَت علينا، وفرضت ثقافتها، حتى صار الهدوء عملة نادرة، وصارت راحة النفس أمنية مؤجلة، وصار صوتنا الداخلي مهددًا بالغياب أمام فيضان الأصوات المتنافرة.
ظاهرة مقلقة
الضوضاء لم تعد مجرد أصوات عابرة في الشوارع، بل تحولت إلى ظاهرة اجتماعية مقلقة تتسلل إلى تفاصيل حياتنا، وتشوّش لحظاتنا الخاصة، وتستنزف أعصابنا، وتسرق منا حقنا الطبيعي في الهدوء. لم تعد تقتصر على الآذان فحسب، بل امتد أثرها إلى أعماق الروح، مخلّفة آثارًا نفسية وصحية لا تُرى، لكنها تنخر في الجسد والوجدان. فالانتقال من أصوات السيارات المسرعة إلى مكبرات الصوت التي تعلو بلا هوادة، ومن ضجيج المولدات إلى صخب الأسواق والاحتفالات، يعكس حقيقة أن الضوضاء أصبحت واقعًا مفروضًا يعبث بالراحة العامة ويُهدد الصحة الفردية والجمعية.
العراق من بين أكثر الدول التي تضررت من تنامي هذه الظاهرة، التي ارتبطت بازدياد الكثافة السكانية، وتفاقم الزحامات المرورية غير المنظمة، وتوسع استخدام مكبرات الصوت في المناسبات العامة والخاصة، من دون أية ضوابط، إضافة إلى صفارات سيارات المسؤولين، وانتشار المولدات الكهربائية في كل زاوية، وتحول المدارس والمعاهد الأهلية داخل الأحياء إلى مصدر دائم للضجيج، وكل ذلك انعكس في صورة متشابكة من التوتر اليومي الذي يعيشه الأفراد، فازدادت معدلات القلق والاكتئاب، وضعفت قدرة الطلاب على التحصيل العلمي، وفقد الناس فرصة العيش في بيئة سكنية متوازنة نفسيًا وصحيًا.
ضوابط البيئة الصوتية
ومع أن المشرع العراقي لم يغفل خطورة هذه الظاهرة، فسنّ مجموعة من القوانين التي هدفت إلى الحد منها، إلا أن غياب التطبيق الجاد جعلها أقرب إلى حبر على ورق. فقد نصّ قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 على منع تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء ومكبرات الصوت، وأكدت المادة 16 منه على ضرورة التزام جميع الأنشطة بضوابط البيئة الصوتية. وأتبع ذلك بقانون السيطرة على الضوضاء رقم 41 لسنة 2015، الذي حدد نسب الضوضاء المسموح بها وفق طبيعة المناطق السكنية أو التجارية أو الصناعية، مع إلزام المخالفين بغرامات أو إيقاف العمل. كما تناول قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 قضية منبهات السيارات وفرض غرامات مالية على استخدامها بشكل مزعج. ولم يخلُ قانون العقوبات العراقي -هو الآخر- من نصوص تعاقب مَن يسبب ضوضاء متعمدة، سواء بدعوة صاخبة للتجارة أو بإحداث أصوات تخل بالراحة العامة.
ثقافة الهدوء
وبالرغم من وجود هذا الإطار القانوني، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف الرقابة، وغياب الجدية في فرض الغرامات والعقوبات، وتهاون الجهات التنفيذية والقضائية في اعتبار الضوضاء تهديدًا فعليًا للصحة العامة. إن ضعف التقدير الرسمي لخطورة الضوضاء جعلها تتمدد في حياتنا اليومية حتى صارت جزءًا من المشهد العام، وكأننا اعتدنا الفوضى وتكيفنا معها.
نحن اليوم بحاجة إلى موقف حازم يعيد الاعتبار لحق المواطن في بيئة صوتية سليمة. فالمعالجة لا تقتصر على وجود نصوص قانونية، بل تتطلب حملات توعية شاملة ترسّخ ثقافة الهدوء وتغرس لدى الأفراد قيمة احترام الآخرين. الإعلام هنا يتحمل مسؤولية كبرى في كشف الأضرار الصحية والنفسية التي تخلفها الضوضاء، والمدارس مطالبة بتربية الأجيال الجديدة على قيَم السكينة. أما السلطات المحلية والأمنية فعليها أن تنتقل من مرحلة التغاضي إلى مرحلة الردع الفعّال، بفرض غرامات رادعة، وتعزيز دور الشرطة البيئية، ومصادرة أدوات الضوضاء العشوائية.
الهدوء ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل حق إنساني أصيل، وشرط أساسي لصحة الجسد وسلامة العقل وجودة الحياة. وما لم تُترجم القوانين إلى واقع ملموس، ستظل الضوضاء قاتلًا صامتًا ينخر في حياتنا ويصادر هدوءنا دون أن نشعر.