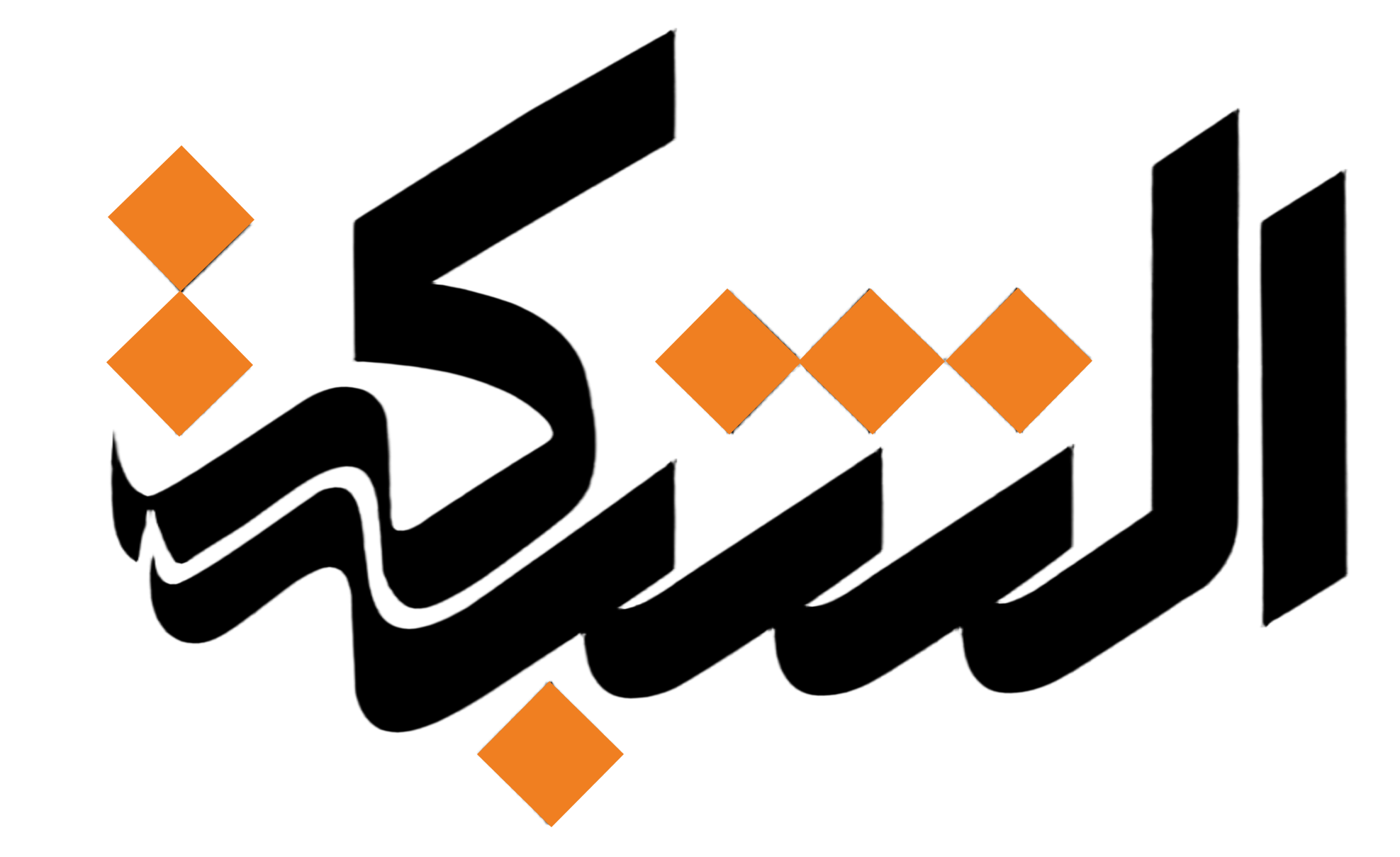100%
جعفر الخزاعي
هنالك محورية بارزة للإنسان بما هو إنسان، بعيدًا عن معتقده في مواضع كثيرة في الدين الإسلامي، ظهرت معالمها في محاور نصية كثيرة في القرآن الكريم والسنّة، وفي منعطفات تاريخية كبيرة، كثورة الإمام الحسين بن علي (عليه السلام).
أركان التعايش
يجد المتطلع أن اختيار الكلمات في الآيات القرآنية، الواردة عن الله عز وجل، كان بطريقة قصدية دقيقة، وليس بطريقة اعتباطية عشوائية. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى ((يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم)) ولم يقل (يا أيها الذين آمنوا)، أو (يا أيها الذين أسلموا)، فإن ذلك يدلّ على إشارة واضحة بمخاطبة البشر جميعهم، بمشتركهم الإنساني حصرًا، بعيدًا عما يدينون من دين أو يعتقدون من معتقد. وتركز هذه الآية الكريمة على تعزيز هذا الجانب الإنساني على وجه الخصوص حينما تذكر في آخرها (لتعارفوا)، وهي الكلمة التي يُفهم عبرها أن المراد ليس تبيين أن الناس مختلفون، بعضهم مع بعض، في المعتقد، ويشتركون في الإنسانية فقط، إنما تدفعهم هذه الآية نحو التعارف فيما بينهم. وهو المضمون نفسه الذي عرض له القول المنسوب إلى الإمام علي (عليه السلام) في وصيته إلى مالك الأشتر التي قال فيها: "الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق." التي أشار فيها إلى أن الدين ليس وحده الذي يدفعنا لنتشارك العيش مع الآخرين، إنما الإنسانية أيضًا ركن من أركان هذا التعايش معهم. عكس ما تدعيه بعض المجاميع المتطرفة التي تبني كل معاملاتها على المشترك الديني وحده، وعدّه المشترك الأصيل الوحيد. وكهذا الأنموذج البشري المتطرف لا ينبذ التعايش عبر المشترك الإنساني فقط، إنما ينبذ حتى التعايش مع المختلف مذهبيًا داخل الدين الواحد، فضلًا عن صاحب الفرقة المختلفة داخل المذهب الواحد، مع أن مشروع الإسلام مشروع وحدة، لا فِرقة.
دروس كبيرة
من هذه الرؤية القرآنية للإنسان، التي عرضنا لها، استمد الإمام الحسين (عليه السلام) ثورته الإحيائية الكبرى، وبرزت ملامحها في كل مفاصل الثورة وحركتها وآثارها، ابتداءً من ندائه (عليه السلام) أعداءه حينما أراد أن يحيي من خلاله إنسانيتهم الكامنة واستنهاض، ولو قطرة، مما تبقى من ضمائرهم المفقودة في يوم العاشر من محرم حينما نادى: "إن لم يكن لكم دين، وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحرارًا في دنياكم…" وامتدادًا بالهدف الذي صدح به (عليه السلام) وبات شعارًا كبيرًا لثورته الذي قال فيه: "إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي" الذي بين فيه أن الهدف الرئيس لهذه الثورة هو إصلاح الإنسان وإعادة بناء منظومته الإنسانية والقيمية والأخلاقية، بسبب ما فعلت به السلطات الجائرة المتتابعة من دفع نحو التسافل الأخلاقي والديني والقيمي، إضافة إلى العزم على إصلاح ذلك المجتمع الإنساني المشوّه، الذي كان قابعًا تحت سلطة سكير أبله، قاتل للنفس المحترمة، وهو أبعد كل البعد عن خُلُق الإسلام ونبيّه (ص)، الإسلام الذي كان جوهره بناء الإنسان وقيمه.
لكن ما هي إلا أيام حتى انتصر الدم على السيف بملايين يصدحون باسم الحسين (عليه السلام) وقيمِهِ ويلعنون يزيدًا ووحشيته. فبعد مئات السنين من استشهاد ذلك الإمام العظيم، رفع محبوه قيمَه وعلّقوها على صدورهم، وأعطوا فيها دروسًا كبيرة في الإنسانية للعالم أجمع، عبر هذه الزيارة المليونية والكرنفال العالمي، الذي تأتي فيه الوفود من كل بقاع العالم لتُقدّم لهم الخدمات كافة من دون أن يسألهم أحد عن دين، أو عن عرق، أو عن لون، أو عن طائفة، وجواز السفر الوحيد للدخول إليه هو الإنسانية وحب الحسين، ليُقدَّم لهم ألذ أنواع المأكل وأطيب أنواع المشرب بالمجان.
إصلاح العالم
لم يكن هذا البذل سوى امتداد لتلك المدرسة الإنسانية التي سطرها صاحبها (عليه السلام)، وإلّا ما الذي يجعل شابًا مراهقًا في عنفوان شبابه يغسل أقدام أناس لا يعرف عنهم شيئًا سوى أنهم جاءوا يزورون إمامه الذي يحبه؟ وما الذي يدفع رجلًا لبيع سيارته الوحيدة ليطعم بثمنها الناس بالمجان لولا تأثره بالعطاء الّذي قدمه إمامه؟ وما الذي يدفع امرأة عجوزًا تترك بيتها المليء بمكيفات التبريد لتصنع الطعام في موكب تبلغ درجة حرارته نصف درجة الغليان لولا أنّها رأت إمامها ينادي العالم والإنسانية، والنار تكوي أجساد أولاده المقتولين أمامه، وهو عازم على إصلاح هذا العالم مما تعرض له من هدم وتخريب؟ إن أبسط ما يقال عن هذه الصور التي يرسمها اليوم محبو الحسين (عليه السلام) هو أنها مدرسة حيّة لتربية أخلاق الإنسان وتهذيب سلوكه، لا يمكن أن يسطّرها غيرهم.