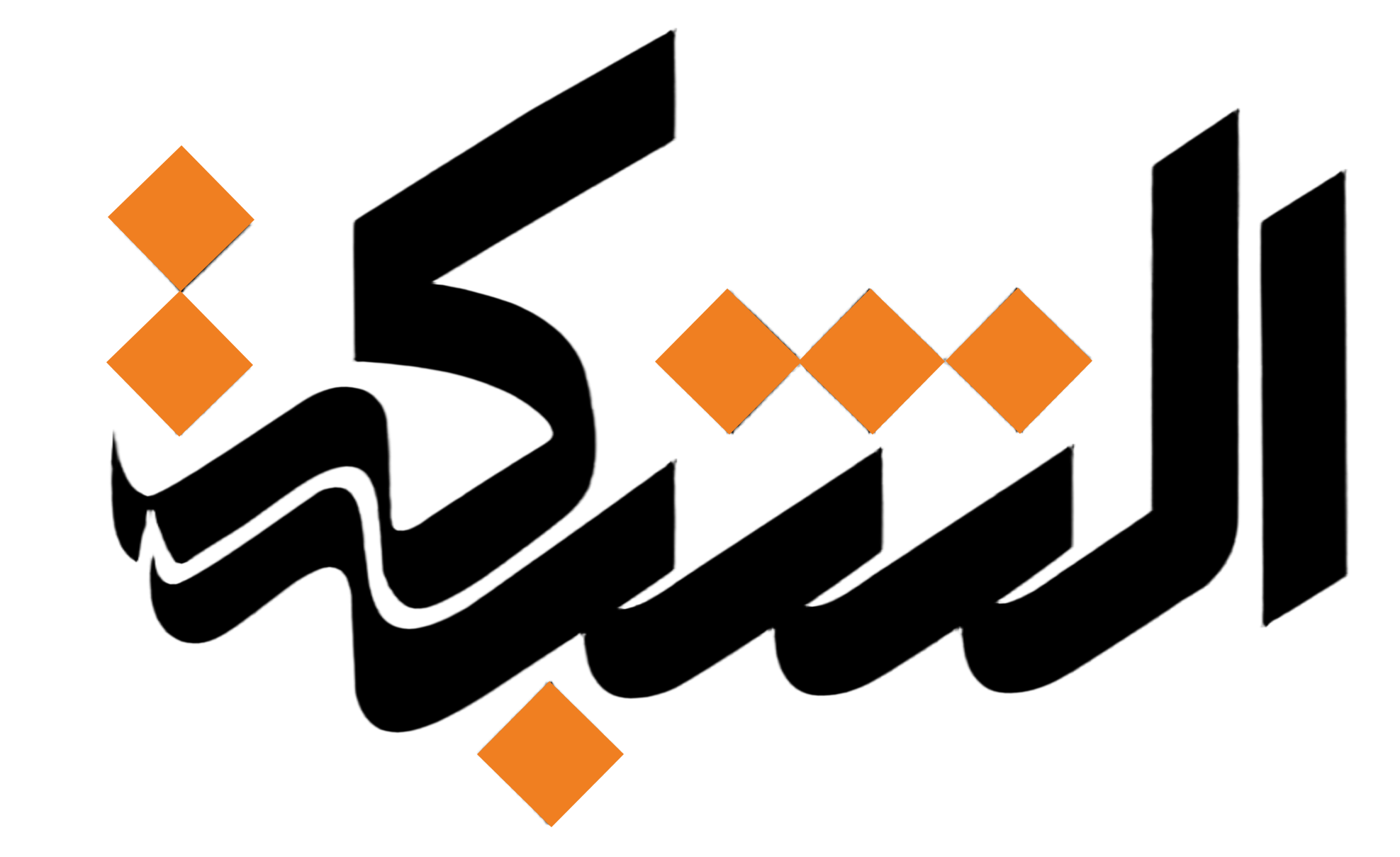علي السومري /
في بلدة ريفية امتازت بتضاريس طبيعتها الخلابة في أعالي الفرات، ومن قرية (راوة)، كانت صرخته الأولى عام 1925، آخر أبناء المعمار الذي شيد جامع المدينة، وفيها تلقى تعليمه الابتدائي، قبل انتقاله إلى بغداد، عاصمة الفن والحضارة. إنه الفنان التشكيلي والكاتب، نوري الرواي، الذي لم ينسَ يوماً تفاصيل قريته الأثيرة بنواعيرها وقببها البيضاء الساحرة، التي تركت أثرها الواضح في مجمل أعماله الأدبية والفنية. كان يرسم كمن يحلم، هذا ماكان يردده على الدوام، وهو ما تجسد في لوحات امتزجت بالخيال والصوفية والذاكرة، خالية من أي تواجد بشري، ومطرزة بقصائد للحلاج وابن عربي وعمر الخيام. ما إن انتقل إلى بغداد في ثلاثينيات القرن الماضي، وإكماله دراسته فيها حتى تخرجه، انصبّ اهتمامه على الأدب، وأصبح صديقاً لأغلب أدبائها، بينهم الشاعر بدر شاكر السياب، الذي كان زميله في العمل آنذاك. كتب في الصحافة وعمل في الإعلام لسنوات طوال، وأصدر العديد من الكتب، بينها (الفن الألماني الحديث)، و(منعم فرات نحات فطري)، و(اللون في العلم والفن والحياة)، و(تأملات في الفن العراقي الحديث)، و(آثار لامعة على مراكض الزمن). كما أقام عشرات المعارض الشخصية والمشتركة، وحاز العديد من الجوائز والأوسمة من داخل العراق وخارجه. لم تكن حياة (الراوي) عابرة، بل حافلة بالإنتاج الفكري والمعرفي والجمالي، من خلال مسيرة قضاها في الفن والأدب وفضائهما، وفي رحيله عام 2014، خسر العراق فناناً منح التشكيل عمقاً ورؤية مغايرة، عبّر عنها بأعماله التي زينت جدران المتاحف المحلية والعالمية. ها نحن نلوح له كلما تسمرنا أمام قببه البيضاء في لوحاته الحُلمية، أو كلما وقعت أنظارنا على أحد كتبه الثقافية، تلويحة استعادة لفنان عاش ورحل وهو يتنفس ألوان حياتنا العراقية.