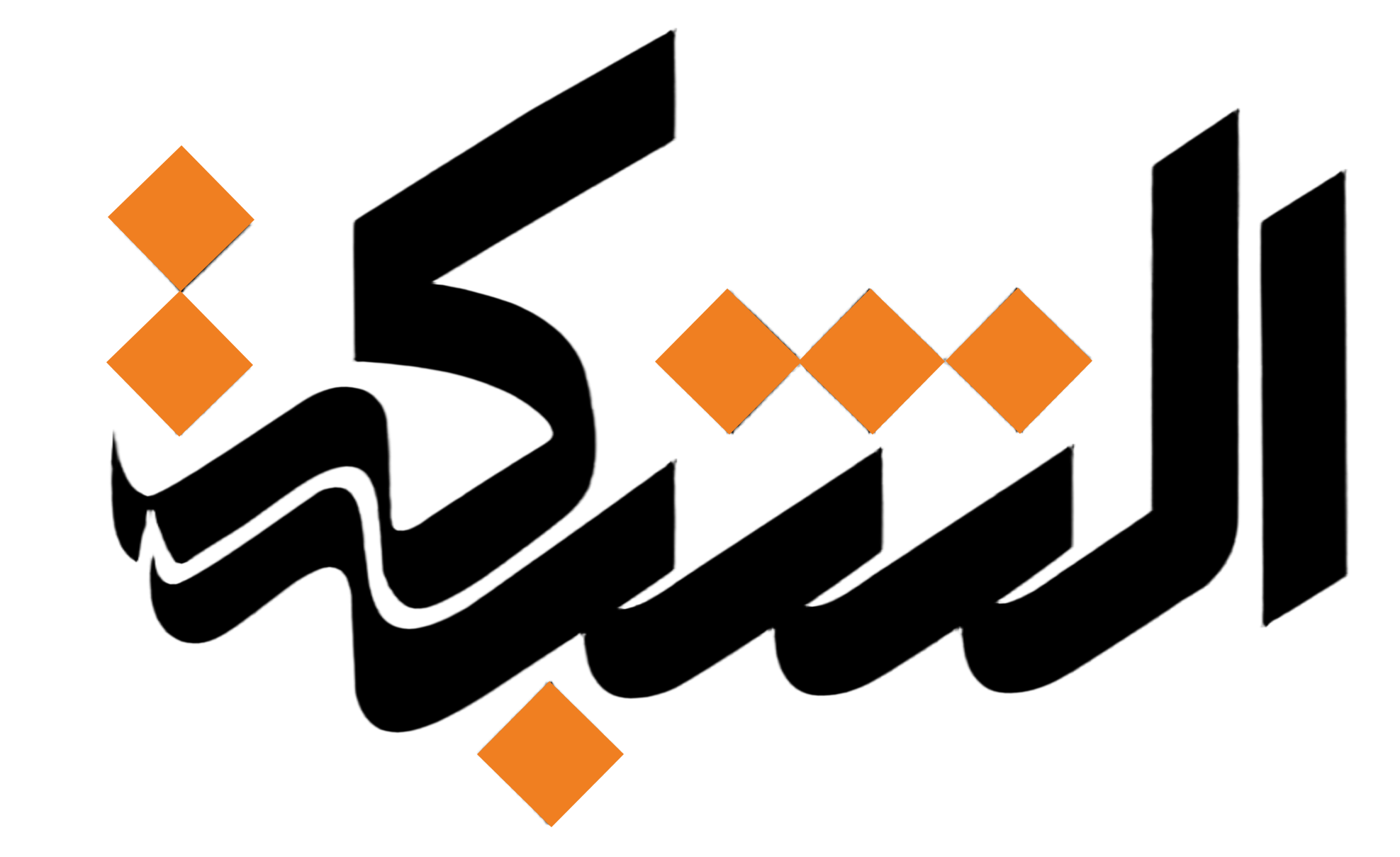100%
ريا محمود
تصوير/ وكالات
كان العيد في بغداد لا يُقاس بعدد أيامه، بل بعدد الضحكات المتناثرة في أزقة المحلات والأحياء، مع رائحة (الكليجة) الخارجة من أفران الصمون، وبأغنية (يا ليلة العيد آنستينا). أما اليوم، فالزمن نفسه ما زال يمرّ… لكن العيد تغيّر.
(كليچة) الجدات
في مساء يوم عرفة، تتحول البيوت البغدادية إلى ورش جماعية لصناعة الفرح. (كليجة التمر) تُعجن بالدهن الحر، و(كليجة الجوز) تُرَصّ بحذر في صوانٍ معدنية، و(كليچة السمسم) تُلفّ بأطراف الأصابع وتُزيَّن بحبّة قرنفل.
لم تكن هناك أفران كهربائية في البيوت، بل كانت مهمّة الخَبز تنتقل إلى فرن الصمون في الحي. يحمل الأطفال صواني (الكليجة)، يمشون بها وكأنهم يحملون كنوزًا، ويعودون بها وهي تفوح عطرًا ودفئًا. وكان صوت الجدّات لا يغيب:
"لا تاكلوها حارة، المعدة ما تتحملها!"
أما اليوم، فصارت (الكليجة) تُشترى من محال الحلويات، ملفوفة بكارتون أنيق… لكن بلا ذاكرة.
ملابس الأم
قبل أن يعرف الأولاد كلمة (ماركة)، كانت الأم هي التي تخيط ملابس العيد بيديها. في الشتاء، تُخاط بجامة من قماش (البازة) المخطّطة، وللبنات (دشاديش بازة) موردة من معمل فتّاح باشا، وفي الصيف تُستبدل بقماش (الكريشة) الملوّن، البارد على الجسد. أما ملابس الخروج، التي اشترتها الأمهات من الأسواق المركزية، أو خيطتها خياطة الحي، فتُعلّق عند رأس السرير ليلة العيد. في الصباح، يُوضع (جزدان العيدية) في الجيب للأولاد، وتعلق الفتيات حقائب صغيرة على أكتافهن، كإعلان رمزي أنّ العيد بدأ.
أما اليوم، فالملابس تأتي عبر التسوق الالكتروني لتصل إلى باب المنزل بعد أن اختارها الطفل بنفسه من أحد مواقع التسوق الإلكتروني، التي تكون غالبًا قد صنعت لرمز كارتوني، أو لاعب كرة مشهور، أو بطلة أنيميشن عالمية، والجزدان تحول إلى محفظة إلكترونية، أو كارت إلكتروني، يتمكن الطفل من خلاله التسوق مجددًا أو شراء الألعاب الإلكترونية.
طابور الوجوه
كان الأطفال يقفون بترتيب دقيق حسب العمر، في طابور صامت إلا من نظرات الشوق. كل واحد يتلقّى (عيديّته)، يخبّئها بسرعة في الجزدان القماشي، ثم ينطلق فرحًا. لا مكان للهواتف ولا للشاشات، بل أحلامٌ صغيرة تُصرف بين (أبو الفرارات) و(أبو السميط) و(أبو شعر البنات). اليوم؟ العيدية تُرسل برسالة هاتف… لا وجوه، لا نظرات، ولا طابور.
صلاة العيد
بعد الصلاة، يعود الأب برفقة القصّاب، وكبش الأضحية يجرّ خطواته نحو قدَره. في الحوش، تُفرش (طشوت) كبيرة و(نجانات) نحاسية وبلاستيكية لوضع اللحم فيها. عادةً، يُقدَّم الرأس والكراعين والباجة هدية للقصّاب، احترامًا وشكرًا.
الوجبة الأولى التي تتصدر السفرة هي (الهبيط): قطع اللحم المطهوة بالتوابل والبهارات، تطبخ في قدر واسع، وتُقدّم فوق تمن عنبر مع شعرية وكشمش ومكسّرات. بعض العائلات البغدادية تطبخ (الطرشانة)، أو القيسي، كما يسمونه في أول يوم العيد، إلى جانب طبق حلوى من حلاوة الشعرية بالهيل، أو حلاوة التمن، أو الحلاوة الجزرية، مع أصناف من البقلاوة وزنود الست والزلابية وحسب المواسم. أما الشاي، فله طقس خاص: يُقدَّم مع (الكليجة)، ومعه عصائر (تراوبي) و(سينالكو) بألوانها الزاهية التي تُبهج قلب الطفل قبل معدته.
(الجوبي) ميدان الطفولة
كل حي شعبي كان يمتلك ساحة تُدعى (الجوبي)، حيث تنصب الألعاب الخشبية بمناسبة العيد: دولاب هواء يدور بصريرٍ خفيف، ومراجيح معلّقة بجذوع النخيل، تُطلق فيها ضحكات الأطفال نحو السماء.
يتجوّل في الساحة (أبو الفرارات)، و(أبو الطائرات الورقية)، و(أبو السميط)، و(أبو شعر البنات)، و(أبو الحلقوم). وفي الختام، يستأجر الطفل (عربة يجرّها حمار أو حصان)، تعيده إلى المنزل وهو يصفّق ويغني مع الأصدقاء.
اليوم.. أُزيلت ساحة الجوبي، وحلّت محلّها شاشة تابلت أو بلاي ستيشن، تُحاكي ألعابًا عالمية.. لكنها لا تصنع ذاكرة.
سينما العيد وأفلام بود سبنسر
في عصر العيد، كانت صالات السينما تستقبل المراهقين، أفلام الكاوبوي، وبود سبنسر، ولقطات القتال التي تملأ القاعة بالتصفيق. أما التلفزيون، فكان يعرض (استراحة الظهيرة)، وأغاني العيد، ومسرحيات الأطفال.
اليوم، العيد نفسه يُشاهَد على الشاشة… لكن من دون قاعة مظلمة ولا رائحة شاي وكليجة.
توصيل جاهز
ربما لا يزال العيد قائمًاً، لكنّ (اللًمة) تراجعت. الأسر اليوم متباعدة، يربطها (غروب في العيدية) لا أكثر. القصاب يأتي بتوصيل، والكليجة تُشترى من المعجنات، والعيديات تُرسل رقميًا. حتى التمن أصبح من (توصيل جاهز).
لكن، بالرغم من هذا، ما زالت رائحة الكليجة تُعيدنا فجأة إلى المساء الذي حملنا فيه الصواني إلى فرن الصمون… وما زال صوت أم كلثوم في ليلة العيد قادرًا على أن يوقظ الذاكرة. العيد تغيّر، لكنّه لم يختفِ… هو فقط أصبح بحاجة إلى من يستحضره، لا من يستهلكه.