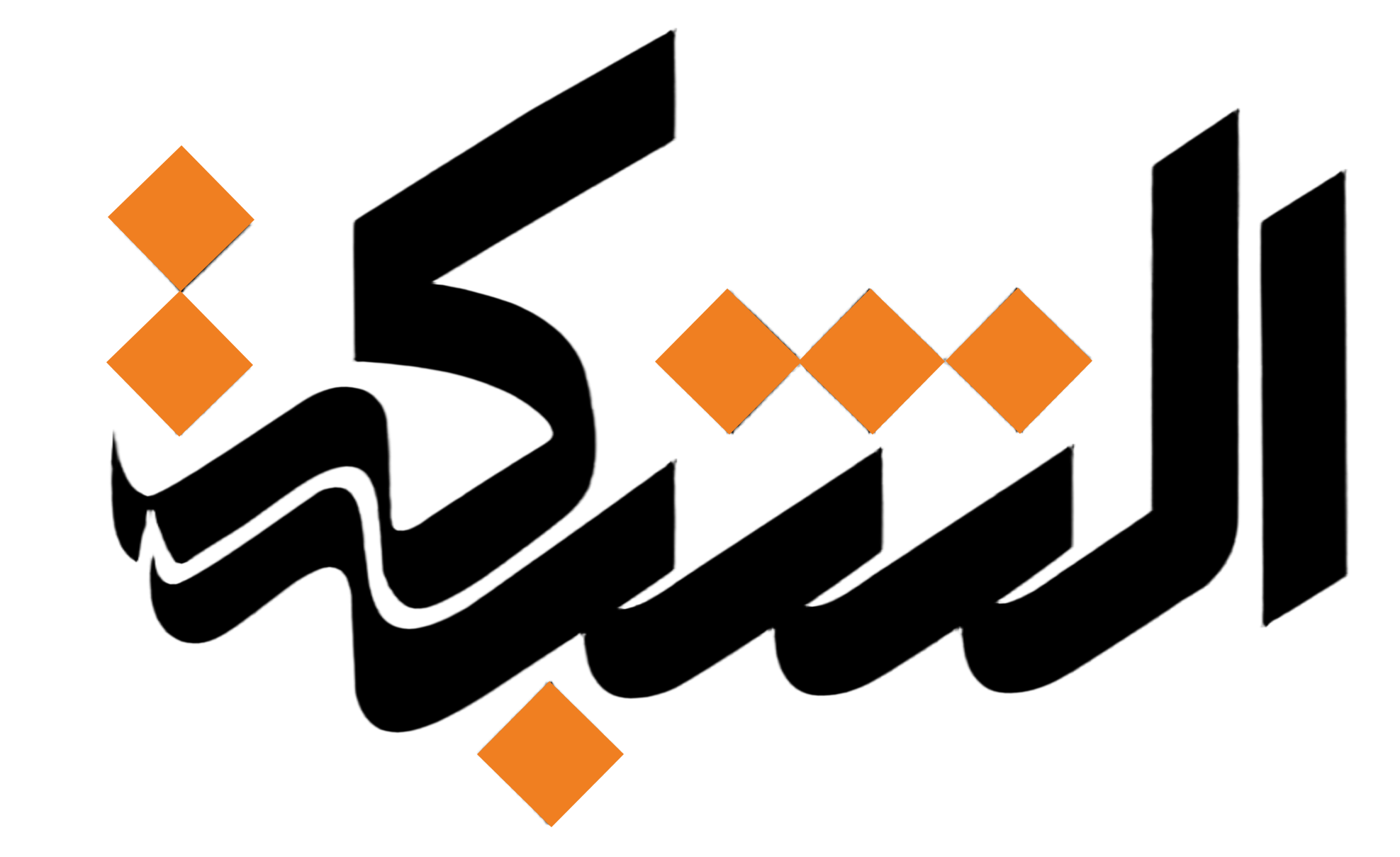100%
حوار / زياد جسام
في هذا الحوار، نقترب من صوت ظلّ وفيًا للكتابة بوصفها مقاومة داخلية، ونجاة شخصية من قسوة العالم. حسب الله يحيى، الأديب والناقد الذي حمل همّ الثقافة منذ شبابه المبكر، يفتح لنا صفحات من ذاكرته، ويحدثنا عن المدن التي تركت فيه ندوبها، وعن الأدب الذي أنقذه من الجهل، والنقد الذي درّبه على مواجهة كل ما يقرأ ويرى ويشعر.
بين الحنين، والاعتراف، والبحث الدائم عن المعنى، يكشف هذا الحديث ملامح مثقف ما زال يؤمن بأن الكلمة يمكن أن تُنقذ، وأن المعرفة لا تشبع منها الروح مهما امتد بها العمر.
*الأدب والنقد، كلاهما انشغال بالرؤية ومحاكمة العالم.. إلى أي مدى أنقذك الأدب من قسوة الواقع، أو فضح لك هشاشته؟
-الأدب بوح، كلام مثقل بعناقيد الكلمات، كتابة واعية، وخطاب يختزن المعرفة ويعمل على تقديم أفضل ثمار هذه المعرفة إلى المتلقي. أما النقد، فليس رؤية مجردة من سلالة الثقافات المكتسبة. إن خلاصة هذه الثقافة التي لا تتقن إثارة الأسئلة ولا نقد السلبيات، ثقافة ميتة، ثقافة هامشية. الأدب كان الضوء الأول الذي جعلني أقاتل جهلي، والنقد جعلني أحاكم كل ما أقرأ وأرى وأسمع وأحس.
* إذا كانت الكتابة تعبيرًا عن التفاعل مع الزمان والمكان، فأين تجد نفسك الآن في هذه المعادلة؟ هل تغيّرت علاقتك بالزمان والمكان ككاتب في هذه المرحلة من حياتك؟
-أنا خزين ثقافات متعددة، في أرصفة مختلفة وأماكن متباينة، وهذا الخزين يتراكم ويتفاعل وتتغير قناعاته في الأشياء: زمانًا ومكانًا ورؤيةً وموقفًا. هذا التغيير الإيجابي، ليس انتهازًا لطرف ما، لا ولمصلحة ذاتية، وإنما كون الإنسان فعلًا وردّ فعل، ولا يمكن له أن يبقى في حالة سكون، إنما يتغيّر على وفق قناعاته ودلالاته وبراهينه وتجاربِه. أنا أحتفظ بقناعاتي، ما لم أجد من له القدرة على إزاحة هذه القناعات والمواقف التي أؤمن بها.
* الموصل، تلك المدينة المثقلة بالتاريخ والحروب، ماذا أبقت فيك من ملامح، وماذا سرقت منك؟
-الموصل ماضٍ، وشمٌ عابر في حياتي، ميلاد لم أحضره، وذلك طعنني في حياتي المبكرة. عندما أصدرت مجموعتي القصصية الأولى (الغضب) عام 1967، وعملت في الصحافة منذ ذلك الوقت، لم أجد من يشجعني على حرفة الكتابة، بدءًا من والدي وأصدقائي، إلى المنابر الإعلامية. الموصل.. جرحي العميق والمعتّق، جذري الذي قطعوه منذ صباي. لذلك وجدت نفسي لا أعرف الطفولة ولا الشباب، وإنما أجد نضجي المباشر في شيخوختي التي سبقت سنواتها الحقيقية .الموصل.. الجنة التي طردني المتطرفون من بهائها، في قلبي ووجداني وذاكرتي.
الموصل لم تسرق مني ما لا أملك، وما أملكه غير قابل للسرقة. أنا وحدي (سرقت) ثمار المعرفة من خزين المكتبة المركزية العامة، بمساعدة مديرها الراحل عبد الحليم اللاوند، الذي حرص على الاحتفاء بعشقي الاستثنائي في هذه (السرقة)؛ سرقة المعرفة من قلوب وعقول كُتّابها الفنية.
الآن، أنا مجرد سائح إلى الموصل، مجرد إنسان تربطه صلة رحم، وقدر من الثرثرة الاجتماعية التي لا أحتفظ بصورتها، لأنها صورة بلا ملامح، وأنا كائن يبحث عن ملامحه في وجوه الآخرين، مثلما يريد أن يجد جدوى في قراءة وجوه ووجدان وفكر سواه.
*حين تتأمل الطريق الطويل الذي قطعته ككاتب وناقد وقاص، ما اللحظة التي تشعر أنها شكّلت جوهرك الحقيقي؟
-أنا رجل دائم النقد لنفسي، أواجهها وأمتحنها وأدينها عندما تستحق الإدانة. أعتقد أنني بدأت حياتي بطريقة صحيحة، فقد تعلّمت منذ وقت مبكر قراءة كتب بعضها نقيض لبعض، لكي أعرف مدى تأثيرها على عقلي وموقفي، وأين أنا منها، وما مدى صحة ما ورد في هذا الكتاب، ومراوغة وفراغ ذاك الكتاب.
أقرأ ما هو ضدّي، ضد قناعاتي، لكي أواجه قناعات الآخر. أنا لا أعمد إلى ترميم أو إصلاح ما أمتلكه من معارف، وإنما أعمل على إيجاد سجال بيني وبين كل ما أقرأ وأعرف من الناس. لذلك حرصت على رفض القراءة التي لا تضيف لي شيئًا، والصديق الذي لا يضيف لي شيئًا. لقد تجاوزت الثمانين من عمري، وما زلت أرى نفسي في أول الطريق، وبي حاجة إلى مزيد من المعرفة، مزيد من الرؤى، ومزيد من العطاء..
أنا الذي لم يقتنع بإصداره 41 كتابًا في القصة والمسرح والتشكيل والفكر والمعرفة.. أعتقد أنني أمتلك الكثير الذي يمكنني قوله، إلا أن الشيخوخة تثقل عليَّ الزمان والمكان، فأختار العزلة، ويكفيني هامش من هواء العالم.
*ةفي النقد، كثيرًا ما يُنظر إلى الناقد كقاضٍ قاسٍ أو مصلح غير مرغوب فيه . كيف تصف علاقتك الشخصية بالنصوص التي تنتقدها؟
-النقد (مسمار أعوج يُراد تعديله). والآن أتساءل: هل أمتلك الأدوات التي تمكنني من تعديل ما هو معوج؟ وهل أمتلك قوة تفوق قوة المسمار (النص، العرض، كلام الآخر)؟ لا بد أن أمتلك القوة التي تفوق أي عمل أتولى نقده، ولا بد لبصيرتي أن تتجاوز بصري، وأن يكون خزيني الثقافي/ النقدي على دراية بتفاصيل أي موضوع أناقشه وأجادله وأكون ندًّا له. لذلك أجد نفسي في تقاطع مع النقد الذي يدور حول النص أو العرض أو الفكرة، من دون أن يضفي عليّ شيئًا، سوى المزيد من الاستعراض والثرثرة. نحن نستقي الأبعاد النقدية من قلب العمل ذاته، واكتشاف نبض هذا القلب والاكتواء به.
* كقارئ ومثقف، هل هناك كتاب أو نص شعرت أنه أعاد صياغتك من الداخل، لدرجة أنك لم تعد كما كنت بعده؟
-أنا منحاز إلى الثقافة الإنسانية، أيًّا كان زمانها ومكانها، أنا أجرّد هذه الثقافة من عنصريتها، ذلك أنني أعتقد أن المفكر المبدع لا يكتب لقوم بذاتهم ولا لزمان بعينه. الإمام علي (ع) لم يكتب (نهج البلاغة) للمسلمين والعرب وحدهم، مثلما لم يكتب حمزاتوف (بلادي) للروس، ولم يكتب شكسبير مسرحياته للإنجليز، ولم يكتب توماس مان (إخوة يوسف) للألمان، تعاليم بوذا ليست للبوذيين، وأرسطو وأفلاطون لم يعودا لليونان، مثلما لم تكن أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب وفيروز للعرب وحدهم، كما أن لوحات بيكاسو خرجت من حدود إسبانيا.
الأمثلة كثيرة، والعطاء الثرّ لا يمكن حصره في جغرافية المكان ولا سكون الزمان، لذلك أجدني أستقي من كل الآبار والينابيع والبحار، ولا أرتوي، وهذه هي المحنة: أن أعجز عن الخلاص من الظمأ إلى مزيد من المعرفة، التي لا أفلح في حلها ولا معالجتها ولا إصلاحها. من هنا أجد نبعًا صافياً في هذا الكتاب، ورؤية ثاقبة في هذه المسرحية، وجمالًا آخذًا في هذه اللوحة، الأشياء يُكمل بعضها بعضًا، وليس هناك من كتاب أو عمل فني يُغنيك عن سواه. هناك صفوة من الكتب، وصفوة من الأعمال المبتكرة، وصفوة من الأصدقاء الذين يشكّلون إضافة في حياتك.
*حين تكتب الآن، وأنت تحمل ذاكرة مشتعلة بالعقود الماضية، لمن تكتب حقًا: للجيل القادم أم لذاتك التي تخشى عليها من النسيان؟
-أكتب ما يفيد الناس، ما يزيد وعيهم، ويزيد إحساسهم بمعنى الحياة، ما يرقى بذائقتهم الجمالية، ما يُذكرهم بإنسانيتهم ونبذهم للحقد والكراهية والتطرف والقسوة والزيف. لا أكتب لنفسي، لأحقق متعة ذاتية، فهذا شأن شخصي، فلماذا أشغل الآخرين بهذا الشأن؟ الكتابة خطاب للآخرين، تنبيه إلى ما يستحق أن أُنبّههم به.. أما إذا عجزت، فلا بد لي من الصمت.