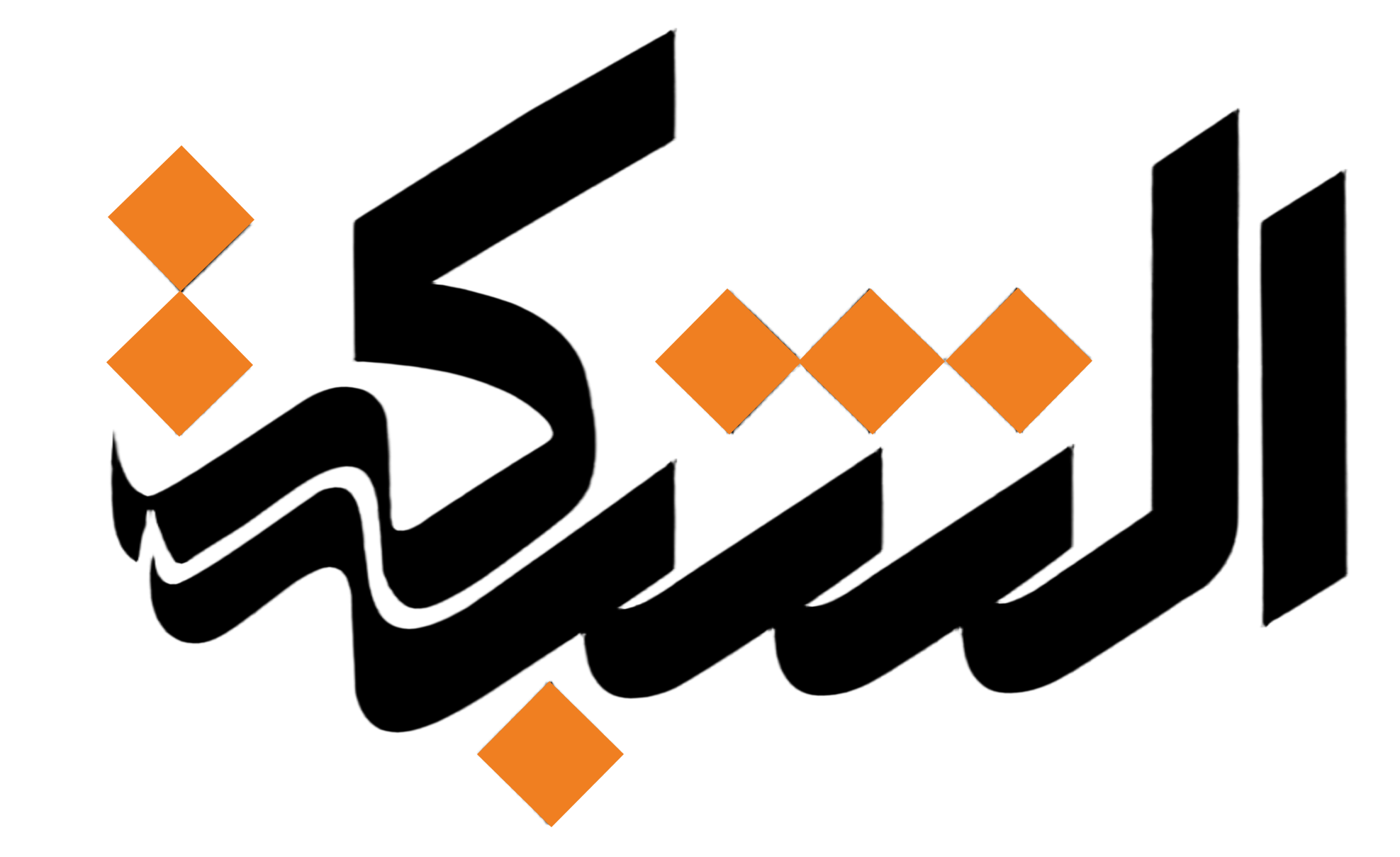100%
د. سلمان كيّوش
تصوير / وكالات
لا تشكُّ جَدّتي لأمّي بحتميَّة المعادلة الوجوديَّة الصعبة: حياة ـ موت، فكلنا نسعى، وهي أوّلنا، إلى الموت، طائعين أو مكرهين. حين كانت تقولُ لنا، نحنُ أحفادها الكبار، إنّ العمرَ قصيرٌ، كانت تومئ إلى أنّها لم تشبعْ من الحياة بَعد. لم تقلْ عبارتها بعربيَّة فصيحة مُحكَمة الضبط النحويّ، بل قالتْ بالحرف: "أعمارنا شربة جكـﮔارة." ولأنّ العبارة مليئةٌ برائحة دخان، تمتدُّ يدها عادةً إلى قوطيَّة (تتنها) وتلفّ واحدة بالمهارةِ نفسها التي تحاولُ فيها إطفاء ما يضطرمُ في نفسها من حرائق.
إلى أنْ جاء اليومُ الذي خفّتْ فيه حاجتُها للتدخين، حين اقتنيتُ مسجّلي (الأكّاي) القديم (أبو التيب). أقولُ خفّت فيه حاجتها، لكنّها لم تنطفئ، فمع دوران البكرة تظهرُ عليها علائمُ ذهولٍ لا عهدَ لنا بها، تُغنيها عن التدخين إلى حين. تبدو مستغرقةً جدًّا، ويقلُّ إطرافُ جفنيها، ويتصنّمُ رأسُها، وتتحيّدُ نظرتُها في جهة واحدة لا تبرحها. ولكي تُكملَ طقوسها تزيحُ عن رأسها عصابتها لتكشفَ عن ثلج شَعرها، تُبعثِرُ نصاعتَه خيوطٌ بلون النحاس، هي بقية حنّاء. تتحوّلُ جَدّتي كلّها، بجلال ملابسها السود، وكفّيها المعروقتين، وقدميها المتصالبتين، إلى أذنين مرهفتين، لا ينقطعُ إصغاؤها إلّا بصيحة منها "بالله اسْ" حين يصدرُ منّا ما يقطعُ إصغاءها المتأمّل.
البكراتُ في صفقة شراء المسجّل كثيرةٌ، جزمتُ أنّي رابح فيها، برغم المائة ألف دينار التي دفعتُها ثمنًا له. البكراتُ منوّعةٌ وإنْ غلبَ عليها الغناءُ المصريّ، ومن بينها بكرةٌ قديمة في شكلها، مكتوبٌ على غلافها بخطٍّ قلق مهزوز: "سيّد محمـد النوري، حفلة أبو علي." حين وضعتُها في المسجّل لأجرّبها كانت جَدّتي راقدة، تغطّي وجهها بطرف عصابتها السائب، وحين انسابَ صوتُ السيّد بآهٍ استهلاليَّة متعرّجة طويلة أزاحتها عن عينيها، واعتدلتْ في جلستها وقد رهفتْ ملامحُها وكفّتْ عيناها عن الإطراف. سألتْ بحزمٍ: "جَدّة ياهو هاذ؟" وقد سالَ إعجابُها بقوامٍ ثخينٍ في ملامحها. ومع تقدّمِ صوتِ السيّد في زفراته، تقدّمتْ حيرتي، فما عدتُ أدري أيّنا، أنا وجَدّتي، أكثر تأثّرًا. كنتُ أنصتُ لمكابداتِ السيّد في حزنه غير المصنوع أو المتكلّف، مع يقيني أنّه يغنّي لحزنه هو، فلا أستطيع افتراضَ تمثّله لحزن مَن يستمعُ له. أستمعُ وأستفيدُ، لأنّ سننَ العشقِ واحدة، ولأنّ الحزنَ المسكوب من (الأكّاي) محكمُ الإغلاقِ عليَّ وعليها.
تُرى، أكانت جَدّتي عاشقةً يومًا ما، واستطاعَ صوتُ السيّد انعاشَ قلبها بذكرى قديمة؟ يجب أنْ أعرف سرَّ انشغالها به مع علمي أنّها تجايلُ السيّد في عمره، وتنغرسُ مثله في مكان جنوبيّ في نشأتها. لذا أجزم أنّها تستمعُ إليه بطريقةٍ أقرب منّي إليه، فهي في الأقلّ لا تسألُ عن معنى كلمةٍ في أبوذية أو دارمي كما أفعل. وتعملَقَ سؤالي في نفسي.
ولأنّها كانت مفغورة الفم، ويكتسي وجهُها بتلاوين الصور الشعريَّة المترادفة، التي يبثّها السيّد على مَن يسمعه، تجرّأتُ وسألتُها بترفٍ: "جَدّة، (وين ياخذج چ السيّد؟)،" يبدو أنّ استغراقَها الغائر في روحها حالَ دون سماعها لسؤالي، فأعدتُه. تذمّرتْ وقالتْ في لحظاتٍ تولّى فيها فالح حسن إكمال ما بدأه السيّد من أنين، فأنطقَ الوترَ بقوسِ كمانه: "جَدّة خلني أهيّس." رغبتُها الشديدة في أنْ "تهيّس" كانت بوحًا مضمرًا لما هو أوضح فيها، فكأنّها قالتْ بلغةِ السيّد، بحذاقته الموجوعة نفسها: "ما بي فوق البكاء ودون (شـﮔـكّة الزيج) قليلًا، ما بي لسعاتُ حروقٍ تأبى الاندمال، ما بي يشبهُ خزعةً من لحم مريض بمرض قاتل." تستمعُ جَدّتي وبوصلةُ رأسها متّجهةٌ نحو الموت، لأنّها تجدُ في صوتِ السيّد ما تحتاجه لمواجهة أهوال الانفراد بالعتمةِ والدودِ، ربّما. وربّما لأنّها لا تحتاج الذرائع لتطلقَ حسرةً، أو تنفخَ في جمرةِ آهٍ خافتة. وربّما لأنّ صوت السيّد يملأ الفارغ من الوجود ويكتسح كمائنه، وربّما ترى فيه "رحّة"، ويدُ السيّد تديرها لتطحن اليابس من أحلامها بسعاداتٍ آتية. وقد تجدُ جَدّتي في غناء السيّد فرصةً لترميم ما عطبَ في علاقتها بوجودها، مع يقيني أنّها لا تبحثُ في إصغائها عن معانٍ للبطولة من أيّ نوع، فكآبتها الغامضة أوضح.
واستمرّ سؤالي في تأجيج مرارتي. أتراها تستشرفُ في إصغائها ما لم يحدثْ بَعدُ من السوء، مع استبعاد فرضيَّة العشق لأنّها محرّمةٌ في عُرف أهلها، أو توشك؟ وضقتُ ذرعًا بحيرتي. فعزمتُ على أنْ أسألَها مباشرةً وبصراحة ووضوح. كنتُ أقف بجانب المسجّل حينها ووجهي نحوه. هيّأتُ لغةَ سؤالي: "جَدّة، ليش تحبّين سيّد محمـد؟" واستجمعتُ قوّتي، واتجهتُ نحو وجهها، لكنّي عدلتُ عنه فورًا لأنّي وجدتُ إجابته ناصعةً حين رأيتُه غارقًا بدمع موفور العافية، ومنزوع البهجة، فأطفأتُ المسجّل.. برغم اعتراضها الكبير.