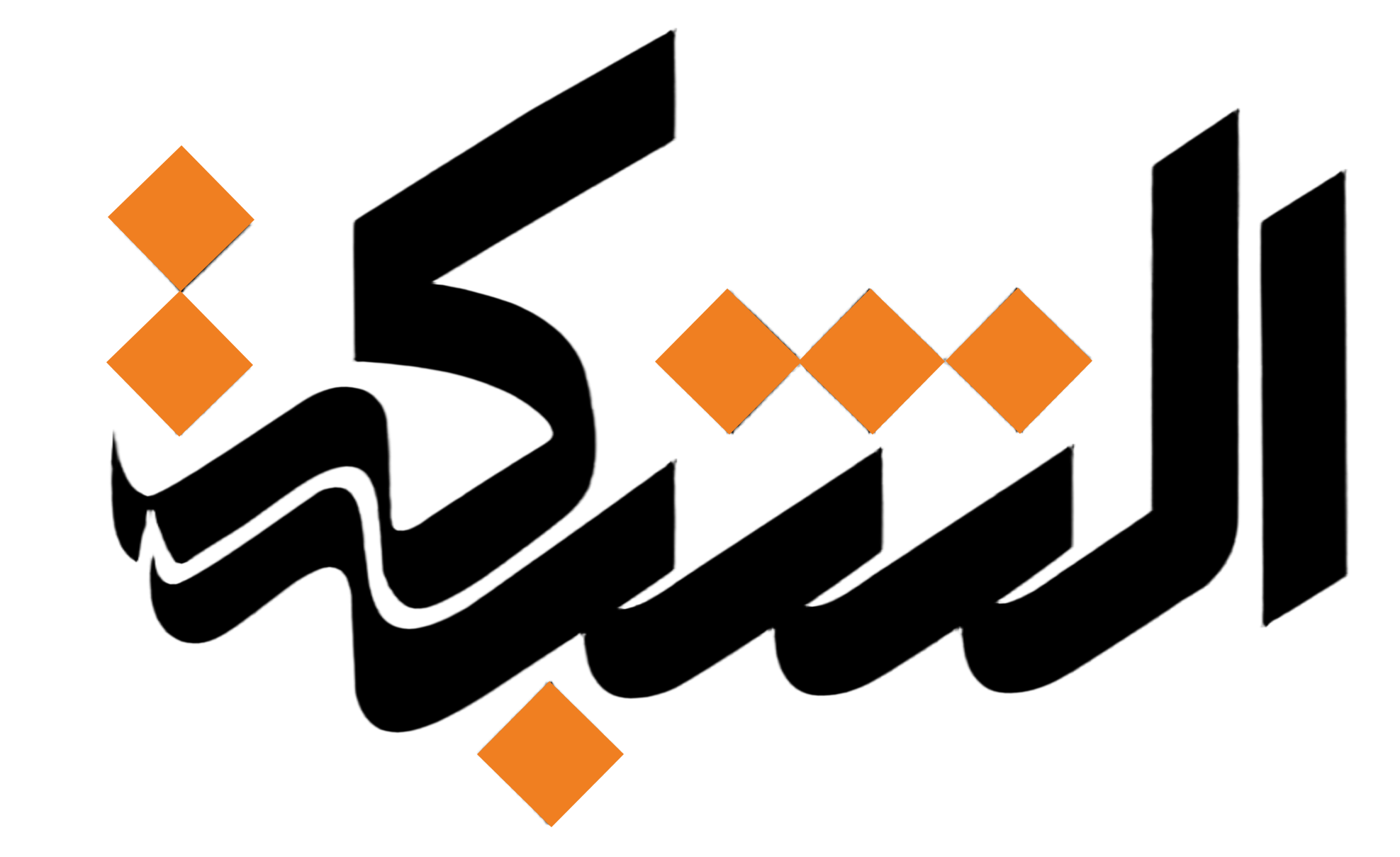100%
عبد المنعم الأعسم
علاقة العرب بالكتاب وبفنون تأليفه وعرضه وأرشفته قديمة، وربما هي أقدم معلَم حضاري إنساني قبل أن تدخل الآلة في تصنيع الكتاب وترويجه. وإذ لم يعرف العرب التأليف قبل عهد الإسلام، فإن الموروث اللغوي، الشعري، نُقل شفاهًا عبر أجيال الرواة، البدويون بشكل خاص. كانت هذه قاعدة الكتاب والتأليف في مراحل الازدهار الثقافي، ابتداء من المدونات البسيطة حتى دور العلم وعقود غزارة الإنتاج ودخول (الكتاب) البيئات العربية المتعلمة ونصف المتعلمة.
ولم تصبح المعلقات وسِيَر عنترة وسيف بن ذي يزن والنعمان ومآثر بني هلال، وهي سرديات شفاهية، وتحقيقات أدبية، كتباً، إلا بعد مئات السنين من العهد الإسلامي، مسبوقة بالقرآن الذي شغل مكان (الكتاب الأول) لمرحلة طويلة بوصفه (لوحاً مسمارياً مكنوناً وأزلياً)، فيما اعتبرت الزخارف والنقوش على البردي، والكتابة على الجلود والأضرحة والأنصاب والقماش، وثائق مبكرة عن مؤلفات تتضمن رسائل أو مداخلات أو أدعية أو وعظاً او سِيَراً. لكن عمليات جمع هذا الموروث الثقافي في كتب، جرت، لأول مرة، في عهد الدولة الأموية، إذ انشغل الكثير من الأدباء والمتعلمين في جمع كل ذلك مع موروث الشعر والرواية وتاريخ شبه جزيرة العرب، كما ابتدأت حركة الترجمة بترجمة أعمال الفيلسوف الصيني (زوسيما)، ثم انتقل زخم التأليف وعلوم الكلام والطبيعة إلى العراق، وحصراً إلى الكوفة والبصرة.
غير أن الانتقالة المنهجية إلى عهد الكتاب، وترويج التأليف والأرشفة والتجليد والبيع، إنما تحققت في عهد المأمون، سابع خلفاء الدولة العباسية "813 - 833م"، الذي اهتم بـدار الحكمة في بغداد لتصبح، منذ ذلك الحين، مركزاً للنشر ومؤسسة للعلوم والتجارب العلمية والمجادلات.، وفي كتاب (تاريخ بغداد). يذكر (طيفور) أن المأمون كان يقوم بنفسه على تجارب علمية حول الهواء والمادة و(قياس الهاجرة)، بحضور كُتّاب كان يملي عليهم نتائج أبحاثه. وقد حظي المترجمون بامتيازات إضافية، فقد كوفئ حنين بن إسحاق "788 - 845 م"، المولود في الحيرة، بما يعادل وزن ترجماته لأفلاطون وأرسطو وجالينوس وغيرهم، ذهباً. وينقل عبد الرحمن بدوي عن المأمون قوله "لله در القلم كيف يحوك وشي المملكة." وهو استلهام لقصيدة أبي تمام، الذي يضع القلم في مقام الموهبة والسيف والعواصف "لعاب الأفاعي القاتلات لعابه".
ولم يقلل من شأن الكتاب ازدراء أبي تمام للقلم في موقف آخر هو (فتح عمورية) "السيف أصدق أنباء من الكتب." فقد أثار هذا سجالاً طويلاً تألق فيه القلم على يد منتقدي أبي تمام، وجرى خلال ذلك رد الاعتبار للكتاب والكاتب.
فإن "الجاحظ مات والكتاب على صدره"، وكان المعتزلي أبو علي الجبائي في النزع الأخير وهو يملي على مساعده مسائل في علم الكلام. ويروى الجاحظ أنه يعرف مَنْ مكث نحو خمس سنين لا ينام إلا وقت السحر، صيفاً وشتاءً، (وهو منكب على كتاب).
وشاءت موجة تأليف وإصدار الكتب أن تنتقل إلى القاهرة وقرطبة والقيروان وفاس وتونس وحلب وطرابلس وفلسطين، ابتداءً من القرن العاشر الميلادي، اتصالاً بحواضر أخرى شهدت حركات تأليف موازية وناشطة، مثل شيراز ونيسابور ومرو وسمرقند وبخارى، فيما كانت بغداد قد احتفظت بموقع مميز في إنتاج الكتاب طيلة هذه القرون، حتى دخول المغول عام 1258م.