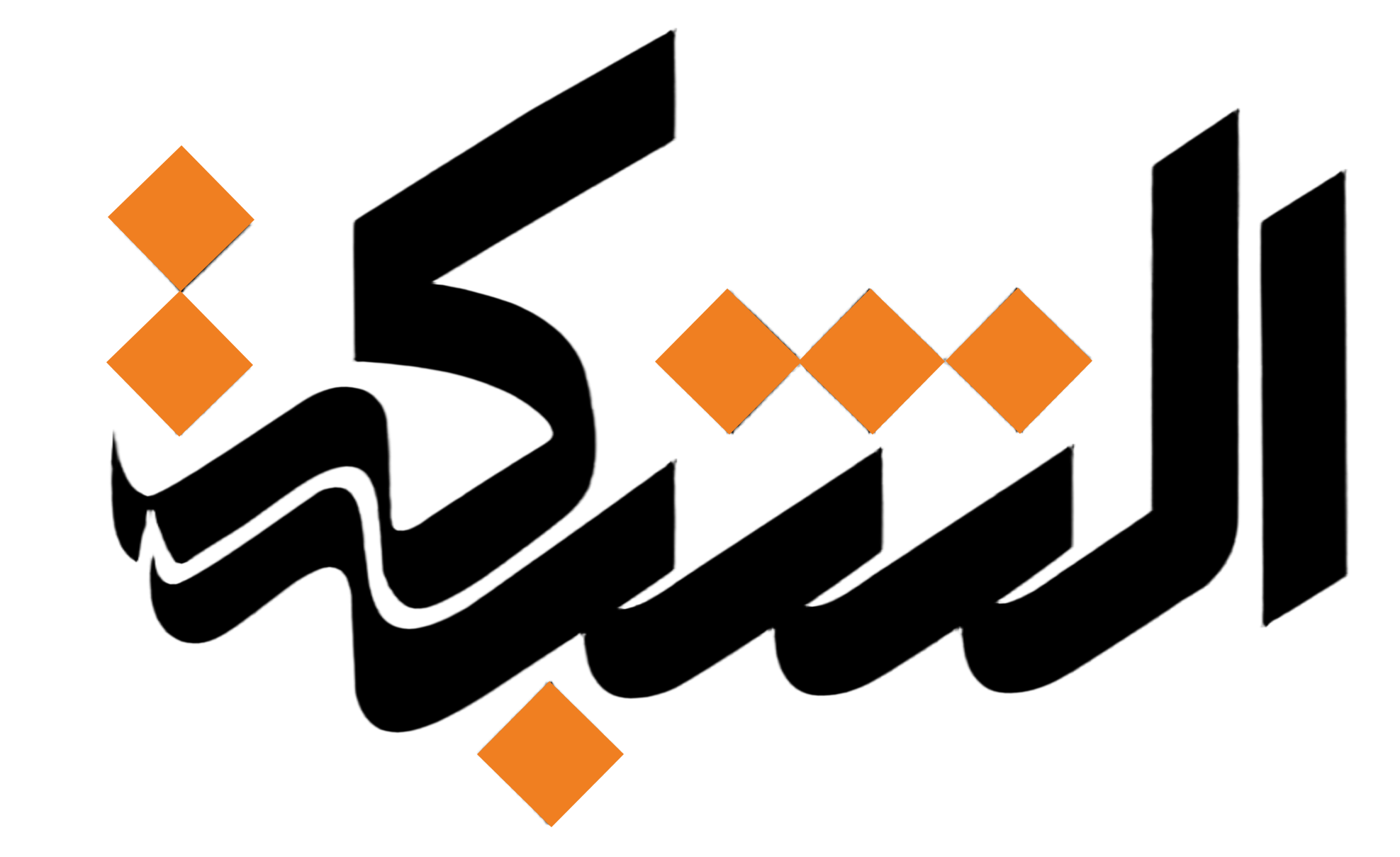نرمين المفتي
عندما نذكر مصطلح "الزمكان"، يتبادر إلى الذهن آينشتاين ومختبرات الفيزياء الحديثة. لكن قليلين يدركون أن جذور هذا المفهوم، بمعناه الثقافي والوجودي، تمتد إلى أرض العراق، حيث خطت الحضارات السومرية والبابلية أولى محاولات الإنسان في فهم العلاقة بين الزمن والمكان. في سومر، قبل أكثر من خمسة آلاف عام، لم يكن الزمن خطًا مستقيمًا، كما تصوره الحداثة الغربية، بل دائرة تدور في طقوس الطبيعة والمواسم والنجوم.
كان الكهنة يراقبون حركة القمر والشمس والنجوم من على الزقورات، ليحددوا مواعيد الزراعة والاحتفالات والقرابين.
في تلك المراقبة الفلكية، تكمن بذرة فكرة "الزمكان": المكان (الأرض والنهر) لا ينفصل عن الزمن (الفيضان والمواسم).
في بابل، تطورت العلاقة بين الزمان والمكان إلى نظام رياضي صارم.
هناك قسمت الساعة إلى ستين دقيقة، والدقيقة إلى ستين ثانية، هناك ولِد التقويم الفلكي، الذي ما زال أثره حاضرًا في كل ساعة من ساعات حياتنا.
لم يكن ذلك مجرد إنجاز علمي، بل تصور فلسفي يرى الكون كنسيج مترابط، حيث يتحرك الزمن في هندسة المكان، وحيث الإنسان ليس سيدًا على الطبيعة، بل جزء من نظام كوني أعظم. إذا كان آينشتاين قد منح "الزمكان" صياغته العلمية الدقيقة في القرن العشرين، فإن العراق منح العالم إدراكه الأول، أن الزمن لا معنى له بلا مكان يحتضنه، وأن المكان لا حياة له بلا زمن يمر فيه.
من سومر، إلى بابل، إلى بغداد، التي جعلت من بيت الحكمة مركزًا لعلم الفلك والرياضيات، كان العراق دائمًا ساحة يلتقي فيها البُعدان. اليوم، بالرغم مما مرّ به العراق من حروب ودمار، يبقى مكانه شاهدًا على زمانه.
دجلة والفرات يواصلان جريانهما منذ آلاف السنين، يحملان ذاكرة الطوفان، وولادة المدن، وانكسار الإمبراطوريات.
هنا يتجلى "الزمكان" في أبهى صورِهِ، أرض تحمل في تضاريسها ذاكرة العصور، وزمن يرفض أن يمحى بالرغم من الفوضى.
حين نعيد قراءة "الزمكان" بعيون العراق، ندرك أننا لسنا غرباء عن هذا المفهوم المعقد، نحن أبناء حضارة عرفت، مبكرة جدًا، أن الحياة شبكة من لحظات وأمكنة متداخلة، وأن الوجود ذاته ليس إلا نسيجًا يمتد من ماضٍ سحيق، إلى مستقبل لم يولد بعد.
ربما يكون هذا الفهم هو ما يحتاجه عالمنا اليوم، أن نرى، في كل لحظة ومكان، امتدادًا لرحلة إنسانية لا تنتهي.