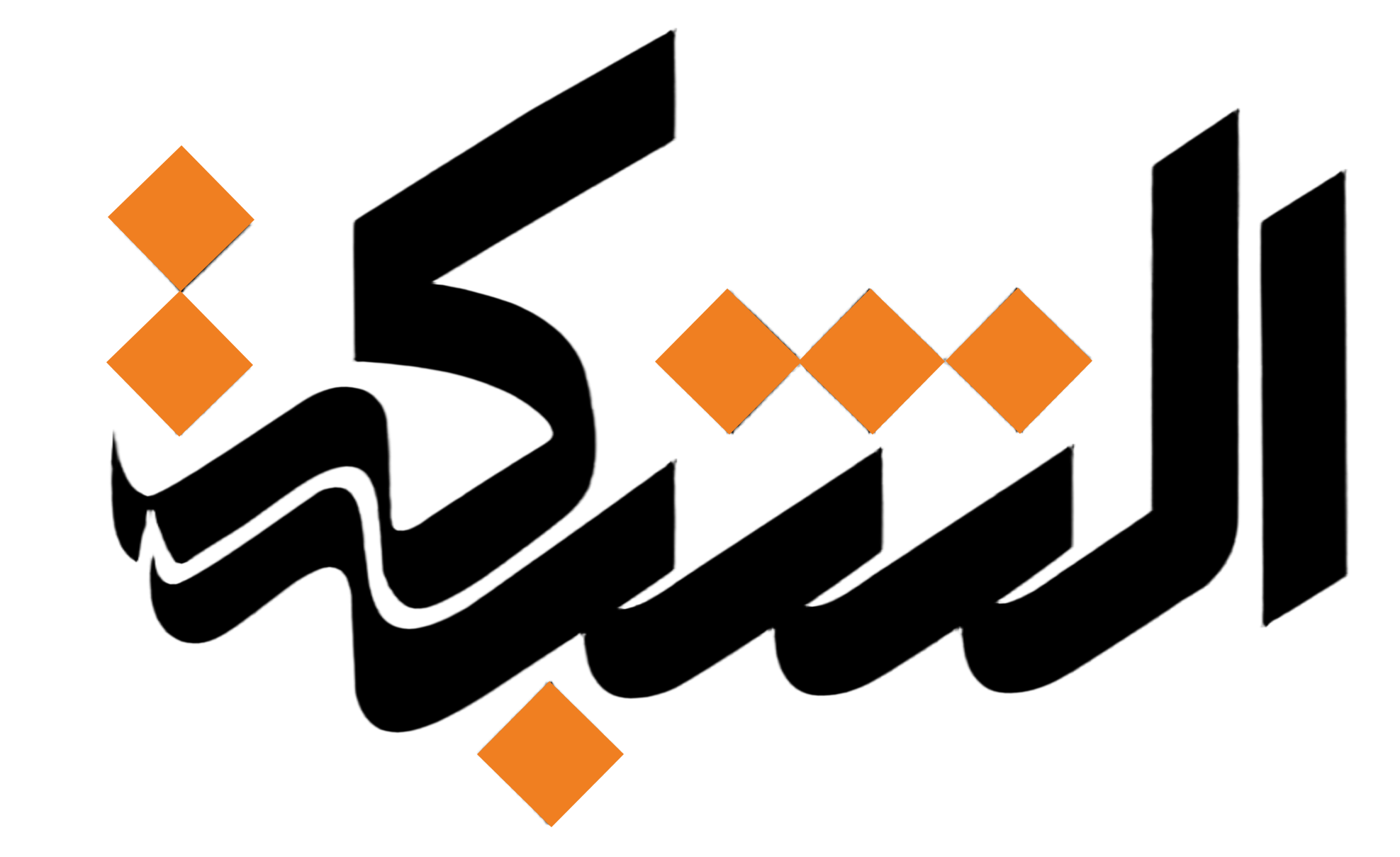خضير الحميري /
تكرار مآسي الحرائق والموت المجاني في مراكز التسوق والمستشفيات، وأماكن الترفيه، وآخرها ما حصل في فاجعة الكوت، يفضح مدى التخلي عن أبسط وسائل السلامة والأمان، التي كان من الممكن أن تنقذ الكثيرين، أو تمنع الحادث تمامًا، ويعرضنا أمام العالم نموذجًا لمن يلدغ من الجحر مرارًا.. ولا يتعظ! لا أعرف لماذا ينظر إلى هذه الأمور على أنها مجرد كماليات، أو ديكور يمكن تأجيله، أو التغاضي عنه. أذكر أننا كنا نتعامل بمثل هذا الاستخفاف، كموظفين، حين كان يجري حشرنا في دورات الدفاع المدني لنتعلم طريقة إطفاء الحرائق بوسائل بدائية. استخفافنا كان ناجمًا من رداءة وقِدَم الأدوات المستخدمة في التمرين الافتراضي. يجمعنا موظف الدفاع المدني في دائرة تضم 20 موظفًا تقريبًا، ويلقي علينا محاضرة يتخللها الكثير من النكات وكلمات الخروج عن النص، ثم تنتهي الفعالية بتجميع بعض الأوراق والأعشاب الجافة على شكل (كومة) يتبرع أحد المدخنين بإشعالها، ونتناوب -نحن المتدربين- على إطفائها باستخدام مطفأة الحريق، التي غالبًا ما كانت تخذلنا بسبب عدم الشحن.. تنتهي الدورة، وتنتهي علاقتنا بالموضوع، وتنتهي المطفأة إلى مشجب مخصص لحفظها من التلف.. والصيانة!! في كل حادثة، تتوجه أصابع الاتهام والإعلام نحو هذا الشخص، أو تلك الجهة، وتُشكل لجان تحقيقية نعرف مسبقًا نتائجها وخلاصة تقريرها الذي يفسر الماءَ بعد الجهد بالماءِ.. إذ تتضافر جهود (المبررجية) لتبرير ما حصل، ثم تخفت الأصوات، وتتلاشى الصور، بانتظار (جحر) آخر نلدغ منه مرتين وثلاث وأربع.. والمذنب الأول الذي يجب أن توجه إليه إصبع الاتهام هو سياق العمل، الذي يجبر كل مؤسسة، أو مشروع، أو معمل، أو قاعة أعراس، أو مستشفى، أو بناية، أو عمارة سكنية، أو سوق، أو (هايبر)، أن يكون مزودًا عند الإنشاء بمنظومة حديثة ومتكاملة للسلامة والأمان، خاضعة للاختبار العملي، وبخلافه لا تمنح الإجازة لمزاولة العمل. الذي يحصل عمليًا هو تدخل (الرشوة)، كالمعتاد، لإبداء رأيها في الموضوع، وتسهيل الإجراءات، خدمة للصالح (العام)، حين يلجأ صاحب المشروع لإرضاء الجهات الإدارية (لتدير ظهرها) عن النواقص، وإرضاء الجهات الرقابية لتتغاضى عن الرقابة.. وكلشي بحسابه!!