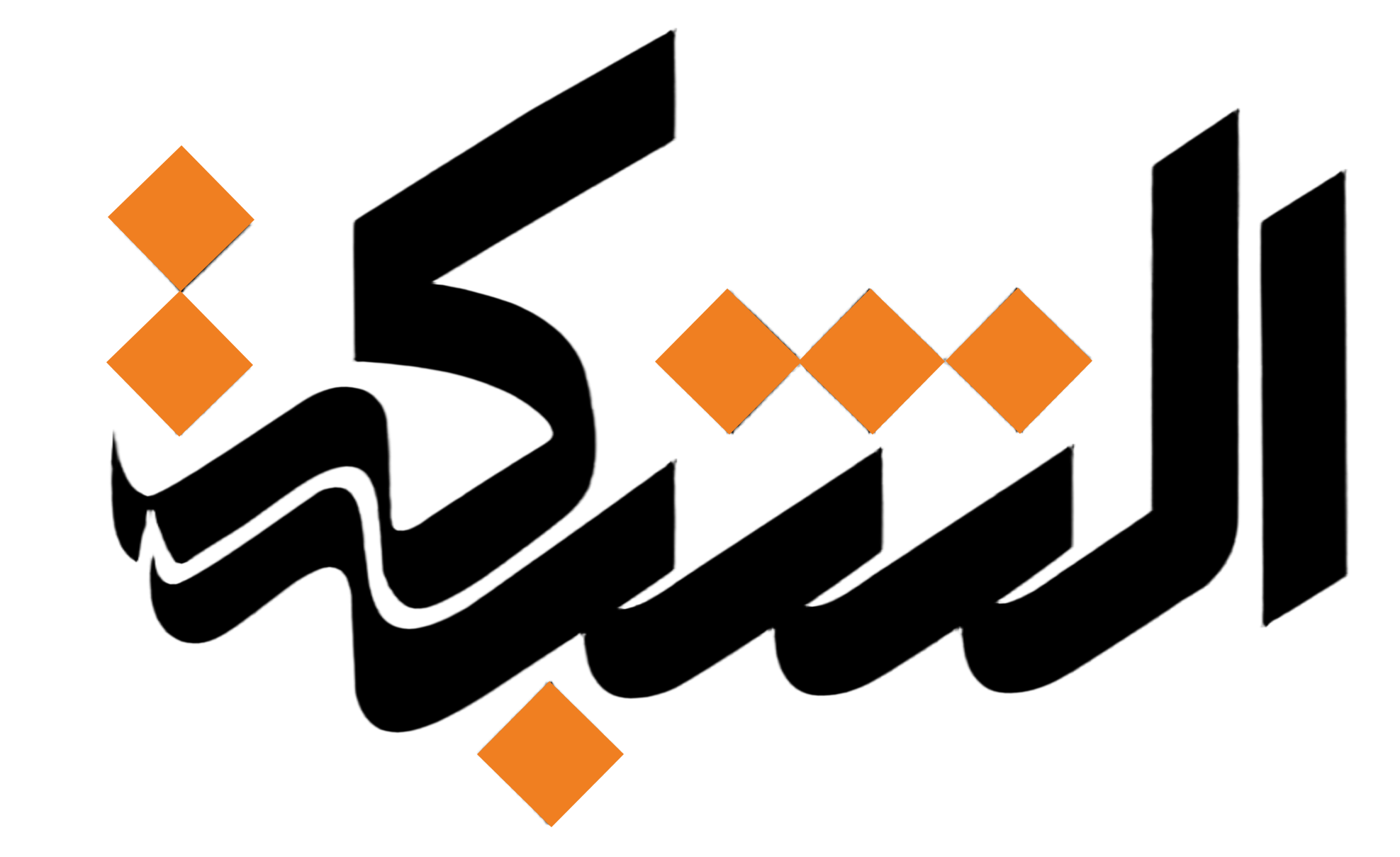100%
عبد المنعم الأعسم
يأخذ الدارسون العرب المعاصرون حكاية (قيس وليلى) باهتمام فاتر، بالمقارنة مع الاهتمام المتزايد بالحكايات العربية المتداولة الأخرى، من مثل (السيرة الهلالية) و (كليلة ودمنة). وفي الإمكان رصد سبب من بين أسباب عدة يقف وراء الإشاحة عنها، يتمثل في طائفة المعطيات والشروح التي تنفي واقعيتها، واعتراضات عدّتها قصة ملفقة، ولا أثر لها في الواقع، وأنها رواية نسبت لأكثر من مؤلف، وخدمت أكثر من منحى. الرواة المشككون يستندون في أصل الحكاية إلى ما أورده (الأصفهاني) في كتاب (الأغاني) عن راوية الشعر في العهد الأموي (أيوب بن عبابة)، وكان معاصرًا لفترة الحكاية، قوله: "سألت بني عامر بطنًا بطنًا عن مجنون بني عامر فما وجدت احداً يعرفه." وعن (أبن دأب) قوله: "قلت لرجل من بني عامر: أتعرف المجنون وتروي من شعره شيئاً؟" قال: "أوقد فرغنا من شعر العقلاء حتى نروي شعر المجانين ..؟" فقلت: "ليس هؤلاء أعني، انما أعني مجنون بني عامر، الشاعر الذي قتله العشق." فقال: "هيهات.. بنو عامر أغلظ أكبادًا من ذلك." ويسجل كاتب تاريخ المغنين، (أبو أيوب المديني)، شكوكه في واقعة الحكاية وبطلان انتسابها لقبيلة بني عامر، فيما يذهب (ابن الأعرابي) إلى أن الشعر القليل المنسوب إلى المجنون، إنما "مُوَلّد عليه"، وينسب (المديني) ذلك الشعر إلى فتى من بني مروان "كان يهوى امرأة منهم." ويقال أن بيتين من الشعر جاءا على لسان المجنون، اكتشف أنهما لجميل بثينة. وأنضم مؤرخون وكتّاب إلى التشكيك بالحكاية، من مثل (الأصمعي)، الذي نقل عنه القول: إن "المجنون ما عرف قط في الدنيا." و(الجاحظ) في قوله: "ما ترك الناس شعرًا مجهول القائل قيل في ليلى إلا ونسبوه إلى المجنون، ولا شعرًا هذه سبيله في ليلى إلا نسبوه الى قيس بن ذريح." اما المدافعون عن الواقعة والنسب وأصل القصيدة، فهم على كثرتهم، من أمثال المسعودي والمدائني والزهري وابن المعتز وأبي المحاسن والعيني، فقد شغلوا إما في تفنيد الشكوك من داخل المزاعم، وتملي التناقضات في الادعاء، وإما في تهجي جداول النسب التي توصل المجنون بقبيلة بني عامر، نسبة إلى عامر، ثم الى صعصعة، بعيدًا عن التعيين المقارن بين وقائع الحكاية وبين المناخ الاجتماعي الذي ساد حقبة الحدث، وهو العقد السابع الميلادي، عقد إرهاصات الانتقال من سلطة القبيلة (الجاهلية) الى سلطة الدولة (الإسلامية). ومما له مغزى ألا تحتل حكاية (قيس وليلى) اهتمامًا من الكتّاب المحدثين، باستثناء شعراء قليلين (أحمد رامي)، حتى أن طه حسين، إذ مر عليها، فقد جعل منها فاصلة في أطروحة الشكوك التي أثارها حول الشعر العربي القديم، وإذ حاول أن يعرضها، فقد لخصها عمدًا في ست جمل: "أحب المجنون ليلى، أراد أن يتزوج بها، أبى عليه أهله هذا الزواج، زواجها بغيره، جنونه، موته."
الى ذلك، تعود أحداث قصة (قيس وليلى)، أو تداولها، إلى القرن الأول الهجري. وقد شبهها مستشرقون بقصة (روميو وجولييت) في طغيان العاطفة المفعم بالشفافية وبالاستعداد للتضحية، وبداهة أن يستبعد أولئك المستشرقون احتمال تأثر مؤلفي القصة العربية بقصة شكسبير، إذ لم يكن الشرق قد تعرف إلى الأخيرة إلا بعد ما يزيد على اثني عشر قرنًا. وإذا انطلقت قيس وليلى على هيئة حكاية آسية لمصير حب عذري، شاءت حياة الصحراء أن تشحنها بالتوتر والمصادفات، فإن أول النصوص المكتوبة عنها يعود إلى ابن قتيبة (المتوفى عام 889 ميلادية)، في كتابه (الشعر والشعراء)، كما أوردها بتوسع، بعد مائة عام، أبو الفرج الاصفهاني في (الأغاني). غير أن أول من رواها شعرًا بعد نحو أربعمائة عام، وصاغها في قصائد ساعدت في تخليدها، هو الشاعر الفارسي (نظامي) مؤلف (الكنوز الخمسة) و(خسرو) و (شيرين) و (إسكندر نامة). وتعد (حكاية قصة المجنون)، لأبي بكر الوالبي، من أكثر المصادر شهرة وثقة، ومنها عبرت الحكاية إلى خارج الاهتمام العربي، وإليها يستند العديد من المخطوطات والترجمات الأجنبية. ويأتي في الدرجة الثانية من الاهمية كتاب (نزهة المسامر في ذكر بعض أخبار مجنون بن عامر) للدمشقي يوسف بن الحسن المبرد. على أن ابن عربي ارتقى بالحكاية إلى الترميز الفلسفي، وأخذ بخيط مرهف منها إلى باحة التأمل العميق في (اللذة الروحانية)، وأعاد بناء الحدث الروائي بحذق مرهف: "جاءت ليلى إلى قيس وهو يصيح: ليلى.. ليلى، ويأخذ الجليد ويلقيه على فؤاده فتذيبه حرارة الفؤاد، فسلمت عليه وهو في تلك الحال، فقالت له: أنا مطلوبك، أنا بغيتك، أنا محبوبتك، أنا قرة عينك، فقال العاشق المجنون لمعشوقته على التعيين: إليك عني، تباعدي عني، فإن حبك شغلني عنك."