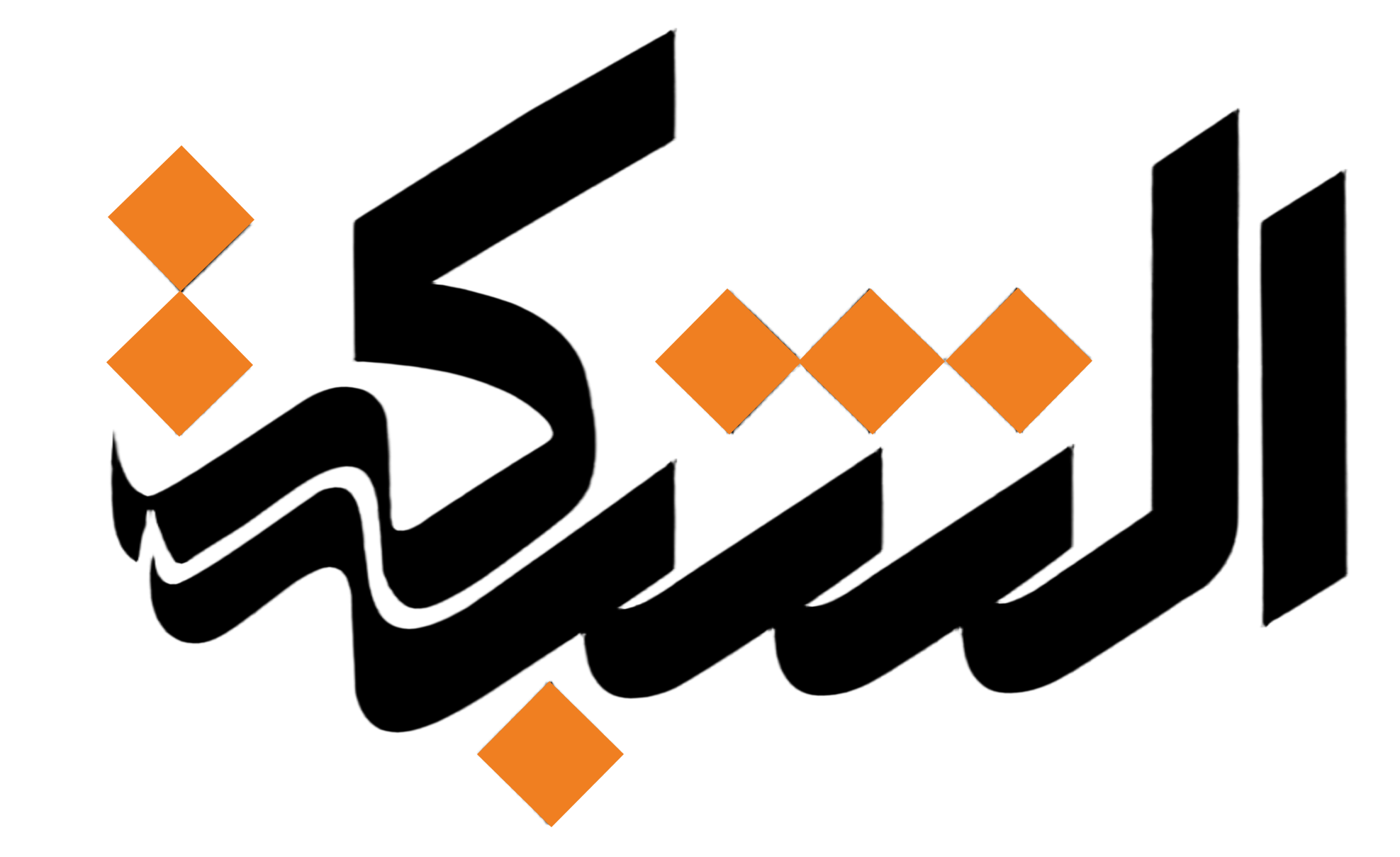100%
ريا الفلاحي
تصوير / حسين طالب
في أناشيد آدم، لا يضع المخرج عدي رشيد شخصياته في مكان محدد، بل يضعها في زمن مُعلّق. قرية على الفرات، خارج المدينة وخارج الزمن، حيث تتجلى الحياة كطيف، والموت كعادة يومية، والتاريخ كظلٍ لا يفارق الحاضر.
الفيلم لا يقول: "حدث هذا في سنة كذا"، لكنه يمرر التواريخ كما تمرر الريح أسماء الشهداء على الجدران: 1946، 1963، 1980، 1991، 2003. كلها محطات محفورة في وعي العراقي، لكنها قد تمر غامضة على المتلقي الأجنبي.
وهذه الفجوة مقصودة – أو على الأقل، متوقعة – حين يختار المخرج أن يشتغل على الذاكرة الجمعية بمرجعياتها المحلية العميقة.
زمن متوقف
قدّم (رشيد)شخصية آدم كمن رفض أن يكبر، جمّده عند حدث واحد: يوم رأى جدّه يُغسّل في مغتسل الموتى. في تلك اللحظة، توقف الزمن، ولم يعد يمضي. لا شيء بعد ذلك مهماً. كل تاريخ العراق – بانقلاباتِه، وحروبه، وحصاراته، وسقوط نظامه – يحدث على الشاشة، لكنه لا يُحدث تغييرًا حقيقيًا في داخله. كأنما آدم اختار أن يعيش في زمنٍ داخليٍ آخر، مقاوم للزمن الواقعي، أو منكرٍ له.
هذا التجميد للزمن يتكرّر بصريًا في الفيلم: لقطات ساكنة، مشاهد طويلة بلا حركة، شخصيات تتحرك في بطءٍ يشبه السُبات. حتى البناء الفني للفيلم – من مشاهد وحوارات وإضاءة – يخدم هذه الفكرة: لا شيء يتغيّر فعلًا، بل يُعاد بصيغ مختلفة.
تجربة غامضة
هنا تكمن المفارقة الجميلة والمربكة في آنٍ معًا: فبينما يشعر المتلقي العراقي بثقل كل تاريخ يُلمّح إليه الفيلم، ويرى صور الحروب والجوع والموت، وقد مرّ بها شخصيًا، قد يجد المتلقي الأجنبي نفسه أمام تجربة غامضة، حسية، شاعرية، لكنها تفتقر إلى السياق. وقد يكون ذلك جزءًا من مشروع الفيلم ذاته: أن يعكس كيف يبدو التاريخ غير المفهوم، غير المؤرّخ، من وجهة نظر إنسان فقد معنى الزمن.
الذاكرة كديكور
من هذه الفكرة، تشكّلت الإدارة الفنية للفيلم. لقد عمل الفريق على بناء فضاءات لا تُمثّل زمنًا واحدًا، بل تتداخل فيها فترات مختلفة. البيوت الطينية، الإسطبلات، مغتسل الموتى، كلها بُنيت من مواد حقيقية – خشب، طين، جذوع نخيل – لكنها عُتّقت بوعي زمني، لتبدو كأنها من الماضي والمستقبل معًا. كأنما هي بيوت علقت في وقتٍ ما، مثل آدم، ولم تُكمل مسارها.
طاقم صامت
بعيدًا عن عدسة المخرج، هناك أعين أخرى كانت ترى الفيلم وهو يُخلق، وتعيد تشكيله لحظة بلحظة. على رأسها كانت عين مدير التصوير باسم فياض، الذي لم يكتفِ بتسجيل الضوء، بل خلقه. استثمر التشققات في الجدران الطينية، ونفذ منها كما تنفذ الذاكرة من الصمت. كانت كاميراه ترصد الحنين، وتُجمد اللحظة كما حُمد الزمن في وعي البطل.
وإلى جانب الضوء، كانت الأقمشة تتحدث بلغة الزمن، عبر تصميم الأزياء الذكي والدقيق الذي نفّذته تمارا النوري، التي استطاعت أن تُلبس الشخصيات لا وفق زمن معين، بل وفق شعور معين: البساطة، التآكل، التكرار، التعايش مع الفقد. ملابس آدم لم تكن مجرد زي، بل كانت امتدادًا لحالته النفسية، وانعكاسًا للبيئة التي توقّف فيها الزمن.
حساسية عالية
أما الأداء التمثيلي، فقد تميز بحساسية عالية، خاصة من النجمتين صفاء نجم وآلاء نجم والبطل علي الكرخي والطفل الذي وقف لأول مرة أمام الكاميرا عزام أحمد، الذين قدّموا شخصياتهم بهدوء داخلي كبير، دون افتعال أو تضخيم، كانت نظراتهم ، حركاتهم، وحتى صمتهم، أدوات تعبير صادقة في عالم لا يحتمل الصراخ.
مساعدة المخرج شهد الطائي، التي كانت تجربتها هي الأولى في فلم طويل، إلا انها كشفت للجميع عن صبر كبير وعمل ومثابرة اكتملت بتوهج المشاهد.
ولا ننسى مهندسة الصوت اللبنانية تاتيانا الدحداح، التي أذهلتنا بتماسكها وخفتها وصبرها الطويل.
ولا يمكن الحديث عن هذا الفيلم دون الإشادة بإدراة الإنتاج المتمثلة بالسينمائي حيدر إبراهيم، الذي كان يعمل مع الجميع بإخلاص عالٍ، علماً بأنه كان وحيداً، وكذلك بالكادر الفني ككل، فنيون عملوا بأقل الموارد، وصبروا على ظروف معيشية قاسية، تقاسموا الأسرّة، والحمّامات، والوجبات البسيطة، لكنهم لم يبخلوا بجهد أو روح. هؤلاء هم الجنود الحقيقيون خلف الشاشة، الذين جعلوا من الطين فيلمًا، ومن التعب صورةً تنبض بالحياة.