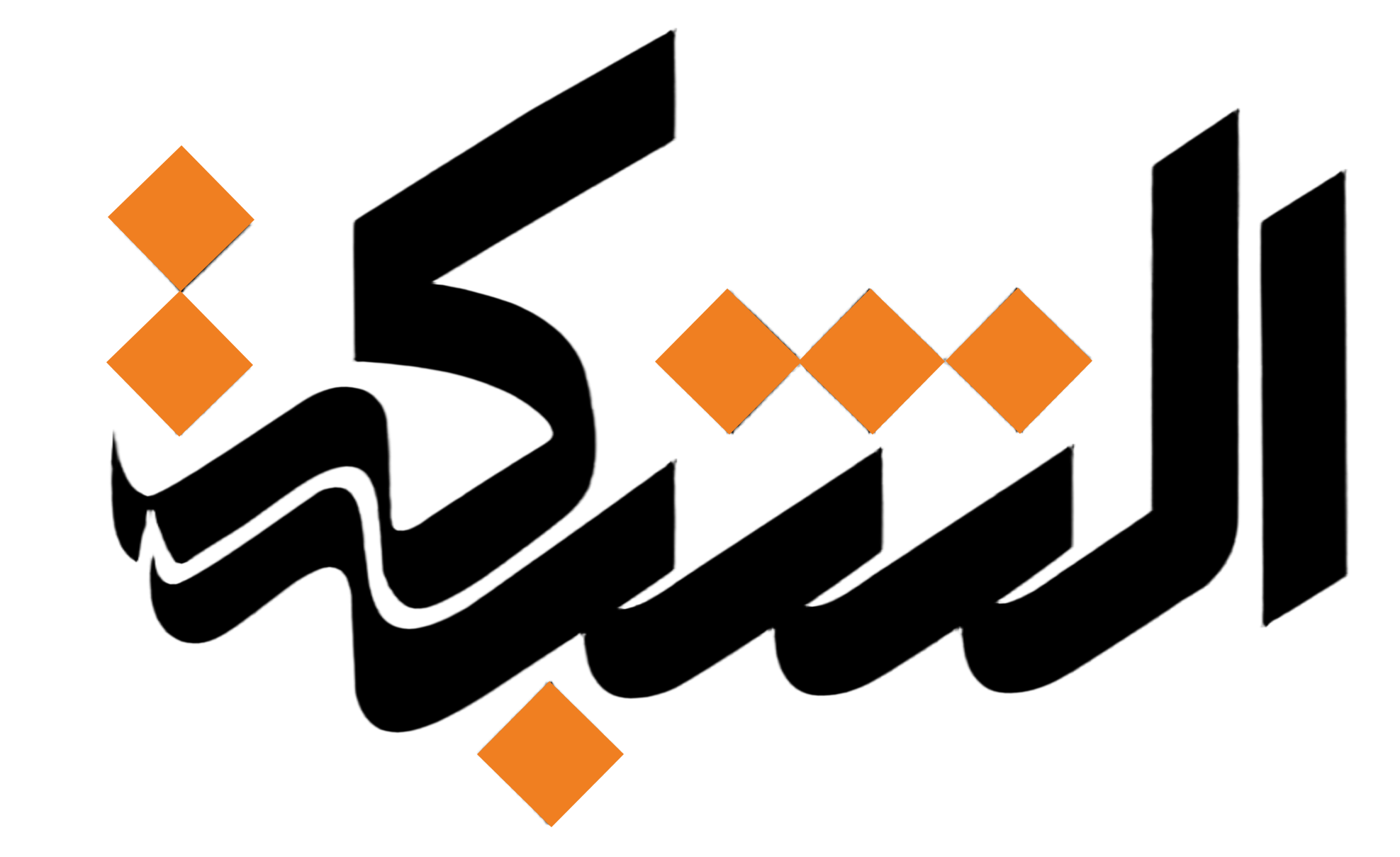100%
علي لفتة سعيد
تعد عملية فك أسرار اللغة السومرية، ورموز كتابتها المسمارية، واحدة من أكثر الفعاليات التي انتفعت منها الإنسانية، لمعرفة الجذور الأولى لتكوينها، هذه التي قد نطلق عليها (الترجمة)، التي كانت واحدة من أصعب مراحل فكّ الرموز التاريخية، خاصة ما يتعلّق بالأسطورة والحياة التي كان يعيشها الأسلاف.
السومريون ابتكروا هذه اللغة التي استعارها منهم الأكاديون لتنتشر كشكلٍ كتابيّ، أو ما يطلق عليه الخطّ المسماري، لكتابات سامية أخرى، كالهندية الأوربية، على غرار السومرية والأكادية والبابلية والحيثية والحورية والعيلامية والفارسية.
هذه اللغة، أو الخط المسماري السومري، دوّنت على أكثر من 130 ألف لوحٍ طيني، فيها السجلات الرسمية وأعمال وتاريخ الملوك والأمراء والشؤون الحياتية العامة، كالمعاملات التجارية والأحوال الشخصية والمراسلات والآداب والأساطير والنصوص المسمارية القديمة والشؤون الدينية والعبادات.
رموز مسمارية
بدأت ترجمة، أو فكّ سرّ الكتابة المسمارية، من قبل العالم الألماني (كارستن نيبور)، الذي تعتبر رحلته التي قام بها إلى الشرق الأوسط هي أوّل رحلة أوربية في مجال الآثار في العصر الحديث، سنة 1761م، مدعومةً من الملك الدنماركي (فريدريك الخامس)، وكان الهدف الرئيس فيها اليمن، لكن الرحلة التي أسهمت في فكّ الرموز المسمارية هي رحلة مدينة (الإصطخر) الإيرانية، فقد وجد فيها الرحالة ألواحًا كتبت بالخط المسماري، فقام نيبور باستنساخ ثلاث نسخ من لوحٍ طينيّ كُتب بالخطّ المسماري وقد كتب بثلاث لغات.
ثم تبعه (كروتفد)، الذي كان يدرس اللغة الإغريقية في مدرسة ألمانية في فرانكفورت، إذ تمكّن، من خلال عملية تحدٍ مع أصدقائه، أن يحل 10 علامات وثلاثة أسماء، ليتبعه (تالبوت وهنكس وأوبرت).
لكن أكثر هذه الترجمات ظلّت بائسةً، كما يقول الباحث والفيلسوف العراقي حسين الهنداوي، حتى تمكّن (هنري رولنسون) من فكّ رموز الكتابة المسمارية في منتصف القرن التاسع عشر، وهو الأمر الذي أحدث قفزةً نوعيةً بعد أكثر من ألفي سنة من قراءة بعض النصوص الأصلية والمهمة من الكتابات السومرية والبابلية والآشورية والكلدانية، المدوّنة بالحروف المسمارية. ويضيف أنه قبل فكّ الرموز، كانت النصوص الدينية اليهودية والمسيحية هي التي تذكر شيئًا عن بلاد بابل، وتكون المصدر الرئيس، بل الوحيد في الغرب.
مؤرخ بابلي
يشير الهنداوي إلى أن المؤرخ البابلي برعوشا (بيروسوس) كان أوّل من نبّه إلى هذه اللغة وأهميتها حين حفظ تاريخيتها، من خلال كتابه (التاريخ البابلي) أو (البابلونيكا)، ليكون المصدر الأهم لدقّتها وشموليتها، فضلًا عن أنه الأكثر مصداقية بطبيعته في عرض مضامين التاريخ البابلي وأحداثه، نظرًا إلى افتراض أن تلك اللغة، موضوعيًا، كانت تعّبر بالضرورة عن روح الثقافة المعبّرة عن المجتمع العراقي القديم، حسب مراحلها وتطوّراتها المختلفة. لكن الهنداوي يشير إلى أن دمار، أو فقدان، النسخ الأصلية لهذا المؤرّخ حرم المؤرّخين والكتّاب اللاحقين من إمكانية الاستعانة بها، فيما تعرضت (الشذرات)، أو المقتبسات النادرة، التي أخذها بعض المؤرّخين منها إلى التشويه والاجتزاء، وحتى الانتحال جزئيًا في الأقل، حتى لدى أشهر الكتّاب والمؤرّخين الكلاسيكيين، الذين نقلوا عنه، مثل اليوناني (بوليستور)، والمسيحي (أوسيبيوس)، واليهودي (يوسيفوس)، وأمثالهم.
ومع ذلك، فإن هذا المؤرّخ كان معينًا للمؤرّخين اللاحقين الذين استفادوا من فكّ رموز الكتابة المسمارية، إذ ترى التصنيفات الغربية لكتابات برعوشا ما يعرف بـ (الشذرات المنتحلة)، أي التي لا علاقة لها بهذا المؤرّخ البابلي بتاتًا. ويذكر بأسف من أن التلخيص الذي وضعه الملك الأمازيغي (يوبا) الموريتاني (نسبة إلى الاسم القديم لشمالي إفريقيا) في جزءين مفقودين، ولم تصلنا منه إلّا المقتبسات المضطربة هي الأخرى، التي نقلها عنه المؤرخان (ايليان) و (تاتيان)، من مؤرّخي القرن الثاني الميلادي، وسواهما من المؤرّخين، ومعظمهم من رجال اللاهوت المسيحي، حيث تواترت عملية النقل والاقتباس منه في العصور اللاحقة.
إن كتاب (البابلونيكا)، الذي أخذ العالم الغربي يهتم به، ويهتم لما قام به المؤرّخ البابلي، يعكس شمولية الرؤية لتاريخ العالم الأرضي، ولذا يدعو الهنداوي إلى الإحاطة والمنهجية الرائعة في التنظيم، وإلى الاستنتاج بأن ما قدمه برعوشا من معلوماتٍ في هذا الكتاب يسمح بمنحه، ليس فقط لقب حامل العلم البابلي إلى العالم، إنما اعتباره أيضًا رائدًا في تطوير فن كتابة التاريخ، بتحويله مهمّة المؤرّخ من مجرّد وصف أحوال الدول والبلدان وتدوين وتسجيل الأحداث وأعمال الحكام كما جرت أو نقلت، إلى أخذها كسلسلةِ أحداثٍ متعاقبةٍ ومترابطةٍ في إطار تاريخ عالمي واحد تقوده العناية الإلهية.
خصائص الإتقان
يتوصّل الهنداوي إلى وجود خصائص امتاز بها منهج (برعوشا) في الكتابة التاريخية، ويجملها بأنه اعتمد في كتاباته على النصوص المحفوظة في المعابد البابلية على أيامه، وأن ذكره لهذه الحقيقة يدلّ على اقتناعه بأهمية المصادر الأصلية، وضرورة وقوف المؤرّخ عليها. كذلك فإن تأليف كتابه باللغة اليونانية يدلّ على تعلّمه أسرار هذه اللغة، واتقانه قواعدها وأساليب المؤرخين اليونانيين، كما يدلّ على اقتناعه بأن المؤرّخ يجب أن يتقن بعض اللغات الأجنبية المعاصرة، وخاصة ذات التراث العلمي الزاخر والمعارف الغنية والتأثير الواسع. ولاسيما أن الحقبة التي عاش فيها المؤرّخ البابلي، شهدت تدوين المؤلّفات القديمة باللغتين البابلية والإغريقية، ولا يشكّ أحد في معرفته اللغة الآرامية التي كانت دارجة في زمانه. فضلًا عن توصّله أن المؤرّخ أدرك أن التاريخ، كتاريخ حضارة، لا يقتصر على النواحي السياسية والعسكرية، بل على الجوانب الفكرية والاقتصادية والاجتماعية.
كما عمد إلى تقسيم تاريخه بين ثلاث دوراتٍ زمنيةٍ، حسب القدم، فضلًا عن توصّله إلى أن المؤرّخ اعتمد على التفسيرات المجازية كما في الصراع بين الإله مردوخ والماء، وما تلا ذلك من خلق السماء والأرض. فقد استعمل طرق بعض الفلاسفة اليونانيين، كي يجعل الفكر البابلي أكثر تقبّلًا ومعقولية. كما حاول التوفيق بين التأمّل القصصي في التعبير والعقلانية المنطقية، كي يجعل منظورات اللاهوت البابلي مقبولةً، مستفيدًا من اطّلاعه على الفكر اليوناني. وذكر أن (برعوشا) نسب بناء الجنائن المعلّقة إلى نبوخذ نصّر فيما نسبتها الكتابات الإغريقية إلى سمير أميس. إن (برعوشا) يبين أن أوّل المؤرّخين هم من الأرض العراقية، وتحديدًا بابل وسومر، وأن ما ذكره في كتبه التي ترجمت، أظهرت صحّة الكثير من المعلومات التي أوردها.
يورد الهنداوي بعضها، وأهمها أنه جعل الطوفان حدًا فاصلٍ بين حقبتين. ثم أورد قوائم بأسماء الملوك الذين حكموا قبل الطوفان وما بعده، بالرغم من أن الأرقام التي قدّمها لسنوات حكم ملوك ما قبل الطوفان، تذهب بعيدًا جدًا مما ورد عنها في النصوص المسمارية المكتشفة حديثًا. ويكشف الهنداوي أن (برعوشا) امتاز بشعوره الوطني وتعلّقه ببلاده والإشادة بحضارتها العريقة في القدم، وتاريخها المجيد، كونه كان يسعى إلى تصحيح التصوّرات والمعتقدات الخاطئة، أو المشوهة، لدى اليونانيين وغيرهم، عن الحضارة البابلية وتاريخ بلاد بابل، وهو ما يعني أن هذا المؤرخ كان صادقًا ويختلف عن المؤرّخين الذين يسعون إلى تغيير الحقائق.