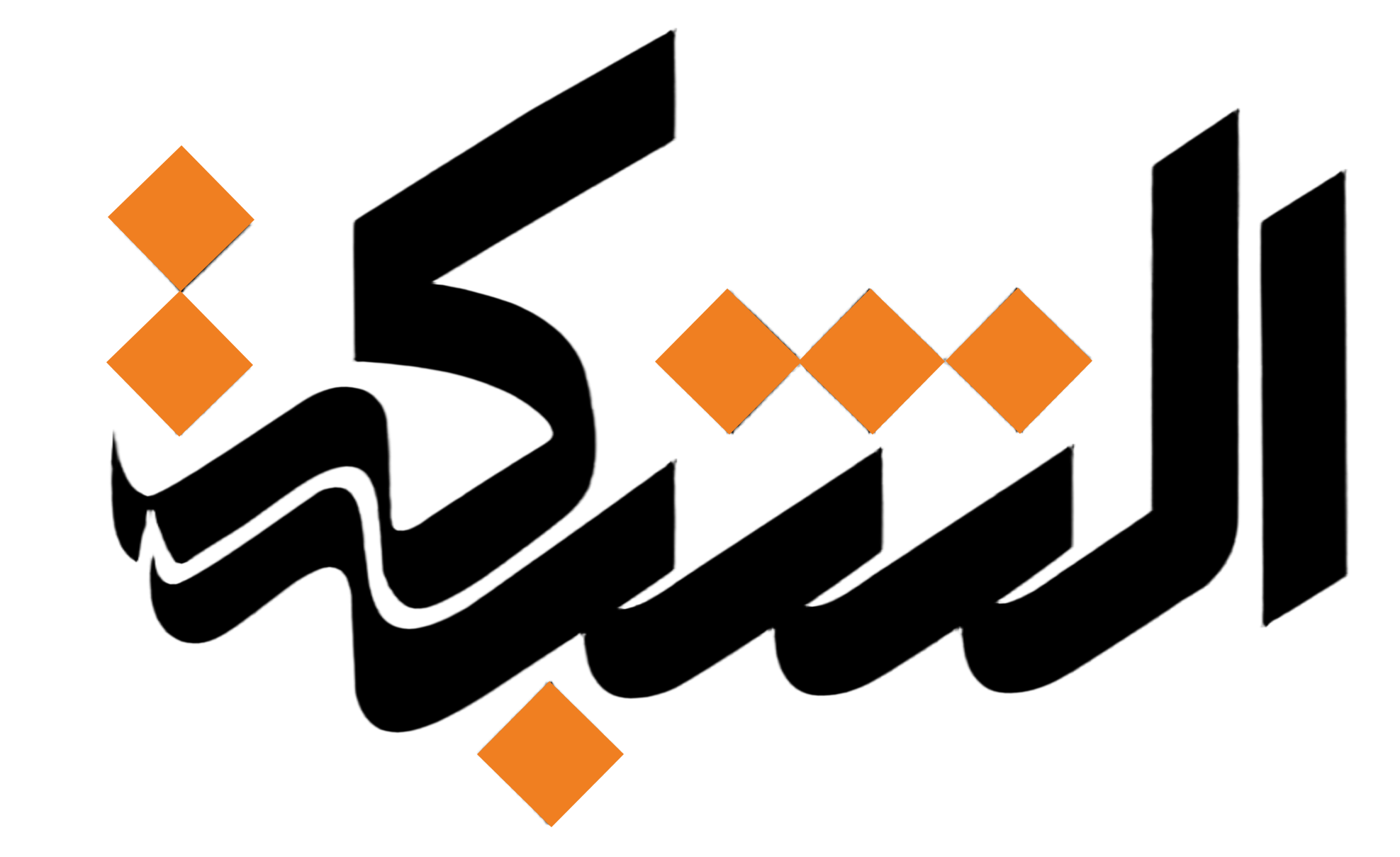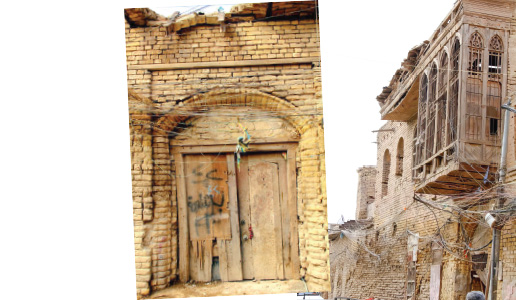100%
رياض شابا
ما إن رأيت صورة تجمعه في مكان إقامته بالشارقة مع الأخ زياد جسام، قبل أسابيع، حتى طلبت من (أبي ديار) أن يجعله يرى الصورة التي تجمعنا، وينقل إليه تحيات بحجم مسافات هائلة تبعد بيننا، وبعمر سنوات أثقلها شوق متراكم، للقاء إنسان ما عرفته إلا عراقيًا صميمًا، بقلب كبير، وعقل أكبر، وطيبة هي الأكبر.
أنا حديث العهد مع (فيسبوك)، بسبب ظروف فرضتها فوضى الهجرة والانتقال، التي جعلتني أرمي بمرساتي في ركن قصي على شاطئ بعيد من غربي العالم، حيث تجتمع ألوان من البشر، يلتقطون أنفاسهم بعد رحلة أنهكتها حكايا القهر والفراق والترحال.
نحو ثلاث سنوات، كنت خلالها أتحين الفرص للتواصل مع أحبة كثيرين انقطعت أخبارهم، ومن بينهم جمعة اللامي، الصديق الذي لا تملك إلا إن تقترب منه منذ الوهلة الأولى، لتألف شخصيةً تجمع دماثة الخلق بغزارة الثقافة وعذوبة الكلام وسحر الهدوء، مسترجعًا بعضًا من صور ومواقف جمعتنا في سبعينيات مبكرة، تنفسنا فيها هواءً مشتركًا نقيًا، خاليًا من أية فايروسات لوثت قلوب كثيرين في أوقات لاحقة.
ثم شاء (القدر المكتوب) أن نفترق لزمن مجهول، يشبه أيامنا الآتية، ودفع هو ثمنها تضحيات يعرفها كل الذين عايشوه أو جايلوه أو أحبوه.
حبه للعراق يشبه العشق المجنون، لا يحده حدود، وعطشه لحرية الإنسان لا ترويه أنهار الدنيا. لا يعرف اليأس أو الاستسلام. وعندما يتكلم عنه محَلِّقا بين هضابه وسهوله وأنهاره وأهواره، تشعر أنك أمام فارس مدجج بالشهامة، وبمشاعل أملٍ لا تنطفئ، مثل هالة قديس.
وهو كان قديسًا عندما يغمض عينيه ويروي حكاياه عن كنيسة (أم الأحزان)، و(محلة التوراة)، وجوامع وحسينيات حاضنته (العمارة - ميسان)، وأحيائها وأسواقها وشطّها، أو عن شعرائه ومؤلفيه المحببين، أو الكتب التي يريد إعادة قراءتها. إذ إن (أبا عمار) وأنا يجمعنا عمر واحد، وتعارُفنا تم داخل دَوامة حِرْفَةٍ مشتركة انغمسنا في هواها حتى الثمالة، بالرغم من الصعاب التي تحَمَّل هو منها العبء الكبير.
لم نعمل معا في صحيفة واحدة، ونادرًا ما كنت أراه في زيارة لوزارة أو مؤسسة، أو في مؤتمر صحفي، لكننا كنا نلتقي بلا موعد مسبق في جلسات مضمخة بعطر مساءات بغداد الحانية، يتكلم بصوت خافت عن أحلام يجب أن تتحقق مهما كان الثمن.. وهو ثمن دفعه من جسده وروحه في غياهب السجون وغربة المنافي وعيادات المشافي لسنوات طوال، عرفنا عنها جميعًا بعد عجافٍ صعبة مر بها، وهو يرى بلاده تُقهر على يد جلادين وعسس وزوار آخر الليل، غلاظ القلوب.
جمعتنا زيارة ميدانية، أو اثنتان، خارج بغداد، أجملهما وأرسخهما في الذاكرة تلك التي كانت إلى الشمال في عام أجهله، ولا تسعفني الذاكرة في تحديد الهدف منها، لكنها تمت في النصف الأول من السبعينيات، وأمضيناها متجولين بين مواقع عسكرية في شتاء راجف. كنت أنا أرتجف بردًا، رغم معطفي السميك نوعًا، وقفازيَّ الجلديين اللذين لم أستطع الاستغناء عنهما، وهو بـ (طرك) (جاكيت) يغلف بلوزة سوداء بلا (ياخة).
(مايبرد لك جمعة؟). يجيبني ضاحكًا: (أمثالي ما يخافون البرد!). نضحك معًا، ثم أدير وجهي ناحية الجبال خلفنا قائلًا: (والله.. أنت تشبه هذا الجبل.)
ولم يكن جمعة يخاف شيئًا ما. شجاعته وصدقه يتكفلان بإشاعة الدفء في أي مكان يحل فيه. ما يَكْمن في قلبه يقوله بلسانه. وما تزال كلماته ترّن في أذنيّ ونحن نهم بالخروج ذات مساء: (أحبه لـ رياض شابا).. (أحبه لـ رياض شابا). ظلَّ يرددها مرات بصوت مسموع وهو يسبقني بخطوات. ولا أتذكر المناسبة أو الدافع بعد كل هذه السنين. لكنني أتذكر جيدًا أننا كنا نتبادل لقيمات من طبقينا المفضلين. (يخرب) ع (الجلفراي الوطني المميز) و (أهلك) أنا ع (التكة العراقية).. وكان هذا (شعار) المرحلة وقتذاك!..
وكان وقتًا لا ينسى، ذلك الذي أمضيته بصحبة جمعة اللامي، الذي تمنيت أن أكلمه مرة بعدما (عثرتُ) عليه، وهو أمر لم يتحقق للأسف، فكنت أعلق أحيانًا على ما ينشره في صفحته، أو أضع إشارة قلب أو (لايك) أو زهوراً على سطوره، في محاولة مني لأستفز ذكرياته.
وردّاً على أحد تعليقاتي كتب يومًا: (من حقنا أن نحلم.. يجب أن نحلم أخي وصديقي الكريم..)
وفي انتظار ذلك الحلم، لم أشأ، ولم أتخيل أنني سأكتب رثاءات عنه بهذه السرعة، عن عراقي حلَّق مبكرًا حاملًا معه حلمه الأخير..!